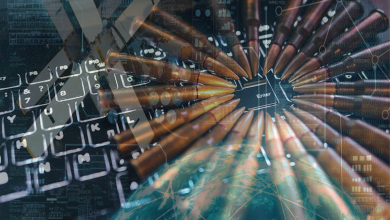بين المتسببين والمنتفعين والضحايا الحرب الصفرية الميكيافيليّة تفرض رجال الأعمال على الساحة
تكاد الديكارتية تُلقي بظلالها على 185 ألف كلم مربع من الجغرافية المحصورة بين شمال يدفَع عن نفسه شرّ عجلة الزمان، وشرق محترقٍ بالمتشظّيات من هذه العجلة، وجنوب يستجدي لقمته بتنفيذ الإملاءات، وغرب أزرق ابتلع الفارين من هذه العجلة. تشقّ العجلة الدائرة طريقها جيئة ورواحا، يُمنة ويسارا، في الاتجاهات الثمان، فتتحوّل الأحداث وكأنّها قطعة صلْب بورشة حداد، تحتاج النار والماء حتى تُصقل لسيف أو حربة أو خنجر؛ طرقة إثر أخرى تليها كثيرات حتى تنتهي من صقل هذا المعدن.
الشك يكاد يأكل عقول السوريين، من المسبّب إلى المنتفع، من موقد نار الشواء هذه، إلى آكل الشواء من اللحوم البشرية، فالتحوّل الجديد على الساحة السورية، لم يكن نتاج مصادفة، إنّما أفرز بشكل متسلسل، وضع برجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، في هذه العجلة التي دارت في الجغرافيا السورية، وحملت ما يربو على 140 ألف شخص خلال شهور قليلة من مواطنهم الأصلية، إلى مخيمات بُنيت على عجل، وكأنّها المبيت ما قبل الموت الأخير لأصحاب الأرض، فجعلت تغيير خريطة السكان حلاً مرضياً على مضض للضحايا، ونتيجة مُقنعة للمنتفعين، و”نصراً مؤزّراً” للمهاجمين.
حرب المال التي أُوقدت في سوريا، ما كانت لتنتهي إلا بربح وفير، فمؤسّسة لافارج التي موّلت عمداً تنظيم الدولة “الإسلامية” بمبلغ فاق 13 مليون يورو، لم تكن لتُقدم على هذا الأمر بسهولة، لولا جشع الربح والاستمرار في الإنتاج والكسب، حيث قادها ذلك إلى ميكافيللية حقَّة، لتدفع المبلغ آنف الذكر، مقابل عبور شحناتها في مناطق سيطرة التنظيم إبان سيطرته على محافظة الرقة، إذ أنّ خروج لافارج كمؤسّسة عن النطاق، عبر اتهامات وجّهت لها بـ “تمويل جهات إرهابية وتجاوز الحظر الدولي على هذه المنظمة، والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وتعريض موظفيها للخطر”.
والتوجّه نحو البدء بملف محاسبتها قضائياً، دفع برجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، إلى البحث عن طريقة جديدة، لا يقفون فيها كموقف وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية، حين جرى تحويله من قبل هيئة المحكمة من شاهِد إلى مُدان، وسرعان ما لمعت الفكرة برؤوس الجميع، وهي اتخاذ طريق المصالحات مع النظام السوري، والتجارة المزدوجة، عبر الدخول في صفقات جدية، بين أصحاب الأرض وصنّاع المكتسبات على مدار سنوات الحراك السوري السبع، وبين النظام السوري وروسيا، والأخير هو المحور الأساسي والبوابة التي أمكنت هؤلاء من الدخول في مثل هذه الصفقات، لطالما قاعدة حميميم هي صاحبة المركزية في إدارة ملفات “المصالحة الوطنية”، التي تحاول روسيا التوصّل إليها، فالروس اليوم بقيادتهم يطمحون أن تضع الحرب أوزارها، إذ عملت روسيا بأساليب ماكرة، إلى تنحية الإيرانيين بشكل عاجل من صفقات “المصالحة”، وجعل النظام السوري ثاني الأطراف، وتحويل نفسها لضامن للعملية من خلال شرطتها العسكرية المنتشرة على الأرض السورية.
اللقاء الأخير بين بشار الأسد وبوتين في سوتشي في أيار من العام الحالي 2018، لم يكن الحديث فيه كلاماً في الهواء، أو تعابير منسّقة لحديث رئيس أحد قطبي العالم، الداخل من جديد لقصره الرئاسي بولاية جديدة، بل كان الحديث هادفاً وبشدة، وما لفت الانتباه فيه جملة داخل حديث بوتين الترحيبي، “إنّ نزع سلاح الإرهابيين في مناطق لها أهمية أساسيّة في سوريا، سيمكّن من إعادة إعمار البنية التحتية بعد وضع حدّ لتهديد العاصمة دمشق”، وهذا ما يدعم الحديث آنف الذكر عن عملية كاملة، رأس الحربة فيها رجال الأعمال وشركات البناء والتعمير والإنشاء، إلا أنّ للقسم المتعلق بتهديد دمشق تفاصيل أكثر لا يسعنا إلا أن نوردها.
فبعد الرفض الإيراني لعملية تل رفعت التي بدأتها تركيا وأوقفتها فوراً، رغم القبول الروسي، وتهديد إيران بمنع تركيا من انتزاع تل رفعت، حتى لو سيقت الأمور إلى حرب بينها وبين تركيا، جرى التحول التركي الكامل في ملفها العسكري في الشمال السوري، إذ تم مقايضة الشمال ببقعة جغرافية أجدى لتركيا، وحليفتها الجديدة روسيا، والتي من شأنها كتم صوت الرصاص وإنهاء القتال فيها، فجرى توسعة نقاط الانتشار التركي في إدلب، والتي كانت مع شمال حماة وسهل الغاب وصولاً لجبال اللاذقية، البضاعة التي جرى مقايضة منبج وشرق الفرات بها مؤقتاً، فالحلم العثماني المتقد، ورغبة القيادة التركية بفصل كرد شمال الحدود عن كرد جنوب الحدود المرسومة قبل نحو 100 عام، والطمع الروسي بنفط شرق الفرات وممتلكات سلّة سوريا الغذائية المتمثلة بالجزيرة، قد يجبر الاثنين على العودة للطمع التركي فيما قبل مقايضتها على الشمال بإدلب، هذا الأمر والذي جرى بتفاهم تركي – روسي، ودفع قوات النظام السوري لسحب أرتال جرّارة نحو دمشق، أسّس لعملية عسكرية في الغوطة الشرقية ومحيط العاصمة دمشق، استثني من عناصرها الإيرانيون وأتباعهم من حزب الله والأفغان والعراقيين، والذين لطالما أنشد منشدوها القصائد التي قيل فيها “جدح من درعا شرر وخصم مهدينا ظهر ومن حرستا ننتظر أول علامة”، لتستفرد روسيا كما طمحت في تأمين دمشق، ولتصل بعد شهر من العمليات العسكرية العنيفة في جنوب العاصمة السورية دمشق إلى اتفاق وقف إطلاق نار كانت هي محورها الخفي.
فرؤية روسيا بأن ليس هناك ما يدفع عنها اتهام التفاوض مع تنظيم مدرج على لوائح الإرهاب العالمي، دفعها لوضع النظام السوري في واجهة المفاوضات، على الرغم من أنّ ملف ريف دمشق الجنوبي المجاور لمخيم اليرموك وحي الحجر الأسود، الذي كان مؤجلاً لما بعد إنهاء التنظيم في جنوب دمشق، جرى تعجيله بمساعي من أحد الجنرالات الروس المسؤولين عن ملف تأمين العاصمة دمشق، وتنفيذه نكاية بضباط الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة الذين زجروا من قبل هذا الجنرال وأمام ممثلي المعارضة في اجتماعات مغلقة ضمتهم جميعاً، لتنطلق بعد المساعي التي أخرجت زهاء 1500 من عناصر التنظيم وعوائلهم إلى الشمال السوري والبادية التي تشهد اليوم معارك عنيفة تبتغي الانتهاء من وجود التنظيم هذا كقوة مسيطرة وتقليل مخاطره على قوات النظام السوري المنتشرة في مساحات واسعة من البادية مع حلفائها من الإيرانيين وحزب الله والميليشيات المدعومة منها.
كل ذلك خلق البيئة المناسبة لانطلاقة رجال الأعمال، فالشراهة اللامحدودة، وسيلان لعاب المتنفّذين مادياً على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي، ودفع إلى عملية تخطيط غير معلنة، لعمليات إعادة الإعمار، بعد عمليات نهب وسلب واسعة شهدتها معظم الأراضي السورية التي عايشت الحرب والمعارك، فكلّ طرف داخل لا يكتفي بالسيطرة فقط، وإنما دخول الجيش الذي جرى تحذير الجزيرة السورية سابقاً منها وقع بالفعل، حين قال أحد ضباط النظام السوري إبان انتفاضة 2004 في القامشلي، أن “احذروا دخول الجيش فهو يقتل وينهب ويسرق ويغتصب ويستولي”، وما كان التأخير في عمليات تسليم المدن سواء في الجنوب السوري أو في أطراف دمشق ومحيطها، إلا جزءاً من التخطيط لعملية تدمير ممنهجة، تقوم على أساس الوصول لنسبة دمار مرضية لنهم الجشاعة من قبل رجال الأعمال والحكومات على حد سواء
النظام السوري الذي يعلم علم اليقين أنّ البساط يُسحب من تحته رويداً رويداً، وأنّ ما استعين به من عسكرة من الدول المتحالفة معه، وضعه كـ “شوفير صينية”، أمام الرأي العام المحليّ والإقليميّ والدوليّ، يُحاول الالتفاف على الاستيلاء الدولي المالي والاقتصادي على مقدراته، ليحفظ لنفسه ورقة رابحة تُنهضه من وقعته المشؤومة في هذه الحرب، التي صبّ هو بذاته زيته على نارها، فعمد لتبديد هذه المخاوف إلى إطلاق أيادِ رجال الأعمال، الذين لم يلبثوا أن أظهروا ميولهم نحوه، بصبغة قلق بان كي موني على مستقبل البلاد، فكان رجال الأعمال أولئك بمثابة الأعمدة الإسمنتية التي يحاول النظام السوري فيها التحرك وفقاً لـ “اقتصاد وطني”، يمكنه فيما بعد إقصاء رجال الأعمال هؤلاء، تماماً كما فعل مع التشكيلات العسكرية التي عمدت لـ “تسوية أوضاعها” عبر استخدامها بداية للتمدّد وتقوية سيطرتها، وتزويد جبهاتها بمقاتلين كانوا أعداءها سابقاً وزجّهم في قتال ضدّ رفاقهم في الحراك العسكريّ السوريّ، ومن ثم الالتفاف على كلّ التعهدات واعتقالهم أول بأول، وكما فعل عند ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية باعتقال عدد من رجال الصيرفة وإغلاق بعض الشركات القابلة للإمحاء، وضخ أموال الشركة في السوق المحلية وتخفيض أسعار العملات الصعبة.
رجل أعمال خارج من حمص مسبقاً، وآخر من حلب وثالث من درعا وآخرون يعملون وراء الكواليس، بدأوا عمليات تحضير للعودة بقوة، تحت الحماية الروسية، فيما معارضة سورية “وطنية” تتجول مع محبوبها الروسي باحثة عن رئاسة البلاد، وتؤمن التمويلات المتناثرة مقابل الخضوع، لعمليات الاتجار بالنفط التي تجري اليوم بين شرق الفرات وغربه، تجري عبر رجل أعمال سوري متنفّذ، مسمّى باسم “قاطراته المغلقة” المتوقّفة لنقل النفط إلى النظام السوري، والآخر يبرّر للنظام السوري والروس عملياتهم في إدلب عبر خلق الفكرة القاضية بأنّ انتهاء إدلب أمر لا محالة، فيما يتاجر آخر كان يمتهن الاتجار بـ “الرقيق الأبيض”، بقضية المجموعات الجهادية في سوريا، عبر بيعها وهو المتستر مع إعلاميين ونشطاء عاملين في صفوف قواته الإعلامية، على وجود هذه القوة المتمثّلة بجبهة النصرة بمسمياتها المختلفة والمجموعات الأوزبكية والتركستانية والقوقازية والإيرانية المقاتلة لجانب المعارضة، في الكثير من الحملات العسكرية والمعارك التي شهدها الداخل السوري خلال الأشهر والأعوام الآفلة.
حرب رجال الأعمال تتقد اليوم بشراسة، وهي بمثابة مرحلة جديدة من الحرب الصفرية التي تعتمدها الدول المتنفّذة في هذا العالم، فبعد الاعتماد الكبير على رجال الأعمال لتمويل تشكيلات عسكرية، تحوّل الاعتماد إلى رجال الأعمال من طراز جديد وبحلّة جديدة، تدخلهم مجال إعادة الإعمار غير المنظور، وللإيرانيين نصيب يعوض لهم خسارتهم المادية والعسكرية تجاه النظام، وهذا ما قد يعدّ حلاً مؤقتاً يدفع إيران لقبول تحييدها العسكري عن الساحة السورية، ولا يُنظر إلى التحليلات القائلة بأنّ الحرب في سوريا قد تمتد لسنوات قادمة، ككلام عابر، بل يجب على الرأي المحليّ والإقليمي النظر إليها، على أنّها خلق مدّ جديد، فآفة السوريين اليوم هي أنّ رؤوسهم لا تزال تنظر إلى ما تحت أقدامهم، ولم ينظر الكثيرون إلى العراق المجاور، على أنّه يغرق في الظلام منذ 15 سنة ونيف، في القتل والموت والتخريب، فلا يكاد يغيب موتٌ حتى يؤتى بآخر، فكلّ القِوى القادمة للمشاركة في الحرب، إنما تبحث عن طرف جديد تضع بصماته على السكّين التي ذبح بها هذا الشعب، وجعل الدمار هو السمة الأبرز، وحوّل البلاد إلى واحدة من أخطر دول العالم، في حين لا يزال العوام المدفوعون من طرف أو آخر، يتمايلون على أنغام مختلفة، ويتراقصون على جثث الضحايا في مشهد يوقع من جديد هذا الرأي العام في حيرة بين المنتفعين والمتسببين والضحايا.