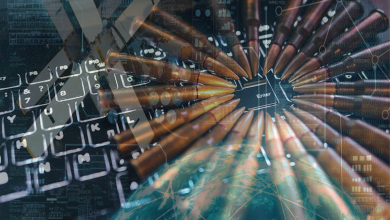من حَلب لآستانة إلى عفرين والغوطة بِيَعُ تركيّة الثّلاث في سوريا
حدود أنقرة – مجازاً – هي حدود دمشق الراهنة، ومشهد عفرين يتبدّى ليس فقط في مشهد الغوطة الشرقية، بل مع المشهد والحدث السوريّ الأكبر نهاية العام 2016.
مقدمة:
يصعُب الأمر على من لا يعرف مكامن الشيطان، ويزداد الأمر تعقيداً حين لا يجري تفصيل المشهد، فالتعميم هو البوابة الأولى للوقوع في المغالطات، وعلى من يودّ معرفة التفاصيل أن يلاحق المشهد وألّا ينفرد بالحديث عن جغرافيا دون أخرى، لأنّ السياسة ترسم خطوط المدفعيّة وتوجّه راجمات الصواريخ وتعطي الإحداثيات للطائرات، لتحقّق المنظور من أهدافها، وتخلق الفسحة أمام الحيثيات حتى تفسح لنفسها مكاناً جديداً، فحدود أنقرة – مجازاً – هي حدود دمشق الراهنة، ومشهد عفرين يتبدّى ليس فقط في مشهد الغوطة الشرقية، بل مع المشهد والحدث السوريّ الأكبر نهاية العام 2016، إبّان إنهاء سيطرة فصائل المعارضة السورية في مدينة حلب.
ستقوم هذه القراءة بسرد بعض الحقائق، والمعلومات ذات الصلة، أنتجها الواقع السوري – المتخبّط ظاهراً، المخطّط باطناً، ولنبدأ بالبحث عن الشيطان الذي يكمن في التفاصيل، والذي انتهى وجوده، ليسكن اليوم في عفرين وعلى تخوم العاصمة السورية دمشق.
البِيعَة الأولى/ بيعة حلب:
يعدّ تاريخ 31 من ديسمبر بتوقيت موسكو وأنقرة توقيتا ذا أهمية كبيرة، فالدب الروسي الجديد المعادي بشكل ظاهريّ واضح للحركات الإسلامية الراديكالية، والعدالة والتنمية التركي المنبثق من حزب الفضيلة الإسلامي، والذي يراوغ في خلق ضبابية أمام الرأي العام العالمي والإقليمي حول موقفه الإسلاميّ. هذا التاريخ السابق الذي كان في العام 2016، لم يكن تاريخاً عابراً، ولا ينبغي تجاهله، لأنّ التاريخ المرسوم هنا، كان نهاية مدينة حلب، التي بيعت جهاراً نهاراً وعلى رؤوس الأشهاد، في صفقة بدت غير معلنة ظهرت نتائجها لاحقاً، كان طرفاها روسيا الحاكمة لسوريا عملياً، وتركيا التي أرادت موطئ قدم لها في الداخل السوري، خاصة بعد تصاعد الحلم الكردي بوصل مناطق الإدارة الذاتية في الجزيرة وكوباني بعفرين المنفردة في أقصى شمال غرب سوريا، فأنتج التقارب الروسيّ بعد مصالحة بين بوتين وأردوغان، عقب إسقاط طائرة روسية من قبل سلاح الجو التركي في الـ 24 من نوفمبر من العام 2015، صفقة جديدة، بموافقة ضمنية من دمشق، تتضمّن إتاحة الدخول التركي كآخر محارب دولي ضدّ تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي، والذي يؤمّن فصلاً جغرافياً بين عفرين من جهة، وكوباني والجزيرة من جهة ثانية، وبالتالي وأد الحلم الكردي، وإجهاض ولادته مبكراً، قبل أن تقع الفأس الكردية في رأس تركيا المترقّبة بقلق حينها للخطوات الكردية المتسارعة، إذ كانت الصفقة بشيء من الاختصار، هو خلق آلية عمليّة لخسارة مدينة حلب، عبر سحب أكثر من ألفي مقاتل من فصائل المعارضة، ممن ينحدر غالبية مقاتليها من المكوّن التركماني، إلى الانضواء تحت راية تركيا، في عملية تحمل الصبغة السورية باسم “درع الفرات”، لتبقى جبهة مساكن هنانو في شمال شرق حلب، والتي كان يعوّل عليها في صدّ الهجوم الروسي – السوري – الإيراني، جبهة هشّة يمكن الدخول إلى أولى أحياء حلب الشرقية من خلالها، ونجم في النهاية انتهاء أمر حلب الشرقية في أواخر ديسمبر من العام 2016، بتهجير جماعي ضمّ قرابة 40 ألف مدني ومقاتل عبر عملية نزوح جماعي إلى ريف حلب الغربي وبعضها إلى عفرين، وسيطرت تركيا وفصائل المعارضة السورية على نحو 2200 كلم مربع من الأرض السورية في شمال شرق حلب، مع ولاء مطلق لمن هم في غرب حلب وشمال إدلب من الفصائل العاملة فيها.
هذا الهجوم التركي على آخر متنفّس حدوديّ لتنظيم “الدولة الإسلامية” معها، والذي بدأ في الـ 24 من أغسطس من العام 2016، تزامن استمراره في العام 2017 مع عملية عسكرية واسعة للنظام عقب أوامر روسية، ودعم تمثّل بإسناد جويّ وبريّ كبيرين، يقودها عميد متمرّس في قواتها وهو سهيل الحسن، مدعوماً بمستشارين روس وبمرابض مدفعية وتغطية جويّة روسيّة، بعمليّة واسعة النطاق بدأت في الـ 14 من شرق حمص، وفي الـ 17 من يناير من شمال شرق حلب، من مطلع العام 2017، والتي كان من شأنها إنهاء وجود تنظيم الدولة “الإسلامية” بشكل نهائيّ من محافظة حلب، وامتدت لتزيل وجود التنظيم بشكل شبه نهائي من كامل البادية السورية حتى كامل الضفاف الغربية لنهر الفرات، باستثناء جيوب لا تزال متواجدة له في بادية تدمر وعلى حدودها مع دير الزور، مع وجودها الذي انتهى لاحقاً في حماة.
هنا تنتهي الصفقة الأولى التي تسامر السوريون على ذكرها، متناسين في الوقت عينه، أنّ حلب بيعت، وأن من يستسيغ طعم الربح، سيعاود الكرّة مرة أخرى، وأنّ التجار يمتلكون قلوباً قويّة بعيدة عن التنجيم، تمضي على أرضية صلبة نحو تحصيل مكاسبها وتحقيق أهدافها.
البِيعَة الثانية/ صفقة آستانة:
عاودت تركيا باتفاق ثلاثيّ لم يحِد الجانب الإيراني فيه هذه المرة، إلى تطبيق اتفاق جديد من شأنه “تخفيف تصعيد العمليات القتالية” على كامل الجغرافيا السورية، في مايو من العام 2017، وهذا ظاهر الاتفاق، أما باطنه كان وقفاً للقتال ضدّ النظام على الجبهات وخطوط التماس، خرقته الفصائل بمعارك جانبية لم تغنِ أو تسمن من جوع، فآستانة الرابعة أطلقت الرصاصة من يد قنّاصين إقليميين ودوليين حاضرين في الحرب السورية، هذه الرصاصة التي أسكتت الفصائل السورية، وأتاحت المجال لحرب على الفصيل الأكبر في سوريا ألا وهو تنظيم الدولة “الإسلامية” المحارَب دولياً، ليزفّ النظام “الانتصار تلو الآخر” في البادية السورية، ولينتهي المطاف بتحقيق أولى أهداف أطراف الاتفاق الثلاثة، ألا وهو الطرف الإيراني، نكاية ضمنية بالوجود الأمريكي على الضفاف الأخرى من الفرات، عبر فتح طريق متصل بري يربط طهران ببيروت، عبر بغداد ودمشق، وليسترضي الطرف الحاضر بقوة إلى جانب النظام السوري، ألا وهو حزب الله اللبناني، الذي من شأنه أن يعمل على تخريب أيّ اتفاق عمليّ مطبّق بعدّة قذائف تطلق من مجهولين في صفوفه.
الطبق المسكوب لإيران وحزب الله اللبناني لم يشبعهما، فكانت في حصّة النظام وروسيا، نصيب لهما، وهو النصيب الذي نالت منه روسيا والنظام وإيران وحزب الله وصولاً للميليشيات المسلّحة المرافقة لهم، والتي تعدو وراء فتات المسروقات والمكتسبات الآنية، لينتهي النظام عند العام 2017، باستعادة أكثر من 65 ألف كلم مربع وفق توثيقات المنظّمات السوريّة العاملة على رصد الحرب على أرض بلادها، فكان هذا المكسب الأول والثاني للطرفين المشاركين إلى جانب النظام بشكل علنيّ واضح وظاهر.
الطرف الأخير لم يكن ليرضى أن يغادر المائدة دون حدّ الشبع، ولا أن تأفل شمس العام 2017 الساطعة، وشتاؤها الممطر، دونما مكاسب تشبع نهمها لإيجاد موطئ قدم آخر في سوريا، وهو الطرف التركيّ الذي استفاد منه نظام بشار الأسد – الخصم الإعلامي له – في إبطاء وتيرة الحرب أكثر من استفادته من الطرفين الروسي والإيراني، فالأخيران قد يزوّدان سوريا إلى أجل غير مرسوم، بالمقاتلين والعتاد والذخيرة، ولكن التدخل التركي كان أنفع، متمثّلاً بوقف مدّ المقاتلين بالسلاح إلا من خلال ولاءات جديدة تبايعه على القتال تحت إمرته، لتحدث البيعة الثالث، بعد أن أنهت البيعتان “مصدرها كلمة باع يبيع” الأولى والثانية أجلهما، وبات لزاماً وجود عدو جديد متواجد في الحاضر التركيّ المرتبط بشكل وثيق بالماضي والمستقبل، أن يحضِّر للمشهد الثالث.
البِيعَة الثالثة/ صفقة عفرين – الغوطة الشرقية:
هنا التاريخ ليس ببعيد، مرسومة بداياته المريبة في العام 2017، ومنفّذ آخره في العام الحاضر 2018، هذه المرة ليست الوجهة تنظيم الدولة الإرهابي، ولا الحركات الراديكالية الإسلامية، فأنقرة المتجهة نحو العثمانية الجديدة، لا تريد تأليب الرأي العام المحليّ عليها، بمعاداة واضحة للإسلام، إذ لا عدو إسلاميّ لتركيا التي لم تكمل المئة عام على تأسيس الجمهورية، بل عدوها واحد واضح، وهم الكرد، وحتى يكتسب الأمر صفة “محمودة”، فقد ألحقت كلمة “الإرهابيّ” به لوصف التنظيم الكردي الحاكم للجغرافية في معظم الشمال، والذي لولا قتاله العقائديّ ضدّ التنظيمات المسلحة الراديكالية الإسلامية، لكانت فصائل المعارضة السورية أو النظام أو حتى تركيا وروسيا، لا تزالان تحاربان الإرهاب على أبواب تل كوجر أو عامودا أو سري كانيه وحتى كوباني وكري سبي، وليتاح للأتراك أمر المسير من غير اعتراض، فقد افترضت معركة عفرين شروطاً وحيثيات للقيام بعملية “غصن الزيتون”، التي أغرقت عفرين بالدماء ألا وهي:
- إيجاد الفرصة الأولى لبدء العملية في عفرين، طبقاً لتعهّدات أنقرة أمام الرأي العام المحليّ التركيّ.
- ربط العملية بالأمن القوميّ التركيّ والأمن الوطنيّ لإبعاد كابوس المناهضة الداخلية من القاطنين على الحدود.
- خلق الأسباب الاستراتيجية للشارع السوريّ حول أهداف هذه العملية.
- ربط العمليّة بدوافع “إنسانية”.
هذه العملية التركية المسمّاة “غصن الزيتون”، كان من المفترض أن تكون ضدّ هيئة تحرير الشام، باعتبارها جماعة “إرهابية” مصنّفة على قوائم الإرهاب، وهي التسمية المحدّثة لجبهة النصرة المعلنة عن نفسها كفرع لتنظيم قاعدة الجهاد العالمي في بلاد الشام، والذي يتزعّمه أيمن الظواهري كخلف لأسامة بن لادن الذي قتِل بهجوم أمريكيّ على مكان تواجده في باكستان إبّان رئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلا أنّ الدخول الأوّل لقوات الاستطلاع التركية في النصف الأول من أكتوبر من العام 2017، تحت حماية هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا”، أنهى هذا التصوّر، لتكتيك لاحق سنأتي على ذكره.
تركيا عمدت في هذه الخطوة إلى إنشاء نقاط تحت مسمى نقاط مراقبة، أمدّتها بالعتاد والجنود، وباتت الأرتال تتجمّع في هذه النقاط جيئة وذهاباً، من مناطق سيطرة الفصائل، إما عبر المنافذ الحدودية الشماليّة مع إدلب، أو عبر المنفذ الحدوديّ الذي يربط تركيا بريف حلب الغربي عبر منطقة كفرلوسين ومحيطها المجاور الرابط بين سوريا ولواء الإسكندرون، وهناك كانت التحضيرات الأولى، التي أسالت لعاب روسيا الراغبة في كسر عظم القوات الكردية، نكاية للمرة الثانية بالتواجد الأمريكي في منبج وشرق الفرات، إذ أعطت روسيا إشارة البدء لتركيا من أجل انطلاق عمليتها عبر سحب قاعدتها العسكرية من منطقة عفرين، ونقلها إلى تل رفعت المسيطر عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية في مطلع العام 2016، حيث بدأت تركيا عمليّتها العسكرية بتحرّك مدروس تمثل بتسلسل تمثل بالتالي.
أوجدت تركيا نقاطاً مراقبة جديدة لها في ريف حلب الجنوبي على تخوم مناطق تواجد العناصر الإيرانية وقوات حزب الله اللبنانيّ، في منطقة العيس المقابلة لمنطقة الحاضر في القسم الجنوبي من ريف حلب، كما أحدثت تواجداً لها في الريف الشمالي لإدلب، بالتزامن مع معركة النظام وروسيا، التي سيطرتا فيها على أجزاء واسعة من الريف الشرقي لمحافظة إدلب والريف الجنوبي الشرقي منها، ومع اقتراب بدء عملية عفرين، كان على تركيا أن تسترضي النظام السوَري وروسيا ليس فقط بتحقيق طموح كسر العظم الكرديّ في عفرين، وإنما بمبرّر معقول يسكت جمهور النظام، فكانت الصفقة الثالثة أو البيعة الثالثة التي نفّذتها تركيا بحقّ المعارضة السورية التي تقاتل في صفوفها، وتعطي المبررات أصلاً وبدون سبب وجيه، إذ أنّ الوجود التركي في إدلب، شكّل صمّام الأمان لتسحب قوات النظام أرتالها من جبهات شرق وجنوب شرق إدلب، مع الإبقاء على ما سيطرت عليه في هذين الريفين، وتتّجه بقيادة سهيل الحسن العميد في جيش النظام السوري، إلى تخوم العاصمة دمشق، حيث غوطة دمشق الشرقية، التي تشكّل مناطق الفصائل فيها نحو 105 كلم مربع من مساحة ريف دمشق المحاذي لشرق العاصمة السورية دمشق، كما شكّل الوجود التركي صمّام أمان آخر لطرف ثاني، وهو الفصائل المعارضة والإسلامية، من هيئة تحرير الشام مروراً بجيش النصر وأحرار الشام وفصائل أخرى وصولاً للحزب الإسلامي التركستاني، التي أوقفت قتالها على هذه الجبهات، باستثناء مناوشات جانبية، تجري من حين لآخر، وتتّجه بهذه الأرتال إلى ريف حلب الغربي المتاخم لجنوب عفرين، وتشارك في العمليات بولاء مطلق تحت إمرة القوات التركية، لمحاربة القوات الكردية المتواجدة فيه، مع الاطمئنان إلى أنّ الجبهات لن تشهد هجوماً جديداً من قبل قوات النظام بهدف التقدّم، كما سبق دفع الثمن المسبق من قبل تركيا في مقابل الدخول عفرين، هذا الثمن الذي صرف شيكاته من بنوك هيئة تحرير الشام والفصائل، ومن بنوك تنظيم “الدولة الإسلامية”؛ حيث صرِف الشيك الأول لصالح النظام عبر السيطرة على أكثر من 440 قرية وبلدة في دائرة متصلة ممتدّة في جنوب حلب وشمال شرق حماة وشرق وجنوب شرق محافظة إدلب، انسحبت منها جبهة النصرة والفصائل العاملة معها بشكل متتالي، يشبه تهاوي تنظيم الدولة “الإسلامية”، فيما صرِف الشيك الآخر من بنك القرى الرازحة تحت سيطرة تنظيم الدولة “الإسلامية”، حيث انسحبت الأخيرة من نحو 100 قرية وبلدة في القسم الشمالي الشرقي من حماة والقسم الجنوبي الشرقي من إدلب، بممرّ فتحته قوات النظام، تلاه سقوط درامي مفاجئ للتنظيم في إدلب، واستسلام زهاء 500 مقاتل مع عائلاتهم إلى تحرير الشام والفصائل، وهذا الشيك كان بمثابة اصطياد عصفورين “المعارضة والنظام” بحجر واحد وهو “تنظيم الدولة الإسلامية”.
الصفقة الثالثة تتلخّص باستقرار جبهات إدلب، مقابل توجّه أرتال النظام لإنهاء أمر الغوطة الشرقية التي يتواجد فيها كلّ من “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”هيئة تحرير الشام”، ومقابل توجّه تركيا إلى عفرين ودخولها دون اعتراض جوّي من النظام، الذي اتفق مع القوات الكردية على إدخال قوات شعبيّة إليها، والتي تسبّبت بخسارة متزايدة في القرى والبلدات، مع تصاعد في الخسائر البشرية على حدّ سواء من المدنيين وفي صفوف الطرفين المتقاتلين المتمثّلين بالقوات الكردية من جانب، والقوات التركية وفصائل المعارضة السورية من جانب ثانٍ.
الحرب الجانبية المصطنعة:
حرب إنهاء الوجود استعرت في إدلب وغرب حلب، قبيل انطلاقة عمليّة النظام، وقبيل أي تحرّك دولي يوقف القتل المتصاعد الوتيرة في الغوطة الشرقية من ريف دمشق، فكان طرفا هذه الحرب هما هيئة تحرير الشام التي استفزّها مقتل أحد قيادييها الجهاديين البارزين في “الجهاد العالمي” أبو أيمن المصري، وحركة نور الدين الزنكي وحركة أحرار الشام الإسلامية بمشاركة صقور الشام وكتائب وألوية التحقت بهذا الاقتتال للجلوس على مائدة الغنائم والمكتسبات المستجدة، إذ شهدت هاتان المحافظتان معارك عنيفة انطلقت عشية يوم الـ 20 من فبراير، في تحرّك استباقيّ تركيّ، لإغلاق الباب وصفقه بوجه روسيا والنظام، أمام الحلّ الأخير الحاضر في أيّ حرب ضدّ فصائل المحافظات الجنوبيّة ومحافظات وسط سورية، ألا وهو نقلهم إلى إدلب، فأُشعِلت الحرب في الشمال السوري وبالتحديد في القاطع الغربي من ريف محافظة حلب والقاطعين الجنوبي والشمالي والأوسط من ريف إدلب، لتقديم فكرة واحدة متمثّلة، بأن لا مكان لانسحاب الطرف المغلوب “الفصائل لاحقاً” إلى إدلب في الوقت الحالي، لتتشكّل معادلة جديدة صعبة الحل في المنظور الراهن، مع استمرار حرب إنهاء الوجود ومعارك “نكون أو لا نكون”، التي يتصاعد فيها الكرّ والفرّ وتبادل السيطرة عبر هجمات متعاكسة بين طرفيّ القتال آنفي الذكر، لحين الوصول إلى توافق عبر وسطاء من “القلقين” على مستقبل الثورة السورية.
كان التدخل الدوليّ قادماً، بعد عجز الأطراف العسكرية المعارضة على أن تكون مسؤولة، فيكاد جنون عنصر واحد يودي باتفاق إقليمي أو دولي كامل، فلم يكن الثقل الأمريكيّ أو الروسيّ أو الإيرانيّ وصولاً للأردنيّ، مع تحييد الدور القطري وإدخال الوساطة المصرية إلى الساحة التفاوضيّة السوريّة، إلا تبلوراً وتجسيداً لهذا التدخل، في هذه التغيّرات التي فرضتها الساحة السورية المتخبّطة، فيما يبقى للدور التركيّ مشهد آخر، أصله فجع العثمانية الجديدة للسيطرة، حاكته المكائد، لينتج حرباً جديدة، يكون فيها التركي هو المتفرّج بينما الصراع العربي – الكردي هو الدائر.
خاتمة:
هذا السرد هو استعراض جمعيّ لجانب من التاريخ السوريّ الحديث، هذا الجانب الذي لا يزال جمع من السوريين، يحاولون أن يختبئوا وراء أصابعهم كلّما دار الحديث حوله، وكأنّ هناك من يريد أن يغطّي الشمس بغربال ويحبس الحقيقة، وفي أضعف حال، يسعى بلطجية الفكر لأن يبرّروا الدخول التركي ويبيعوا الثورة بمدنها ورجالها ومعاقلها ومبادئها، مقابل جشع تركي يهدف لاستعادة العثمانية بأدوات قومية تركية بحتة، تتخذ من الإسلام دريئة لها وشماعة تسحب فيها الجهاديين الإسلاميين إلى مصرف صحيّ، بعد أن أناطت الدول الكبرى، بتركيا، مسؤولية إنهاء وجود الجهاديين وتصريفهم، وبخاصة غير السوريين منهم والذي دخل آلاف مؤلفة منهم عبر الأراضي التركية.