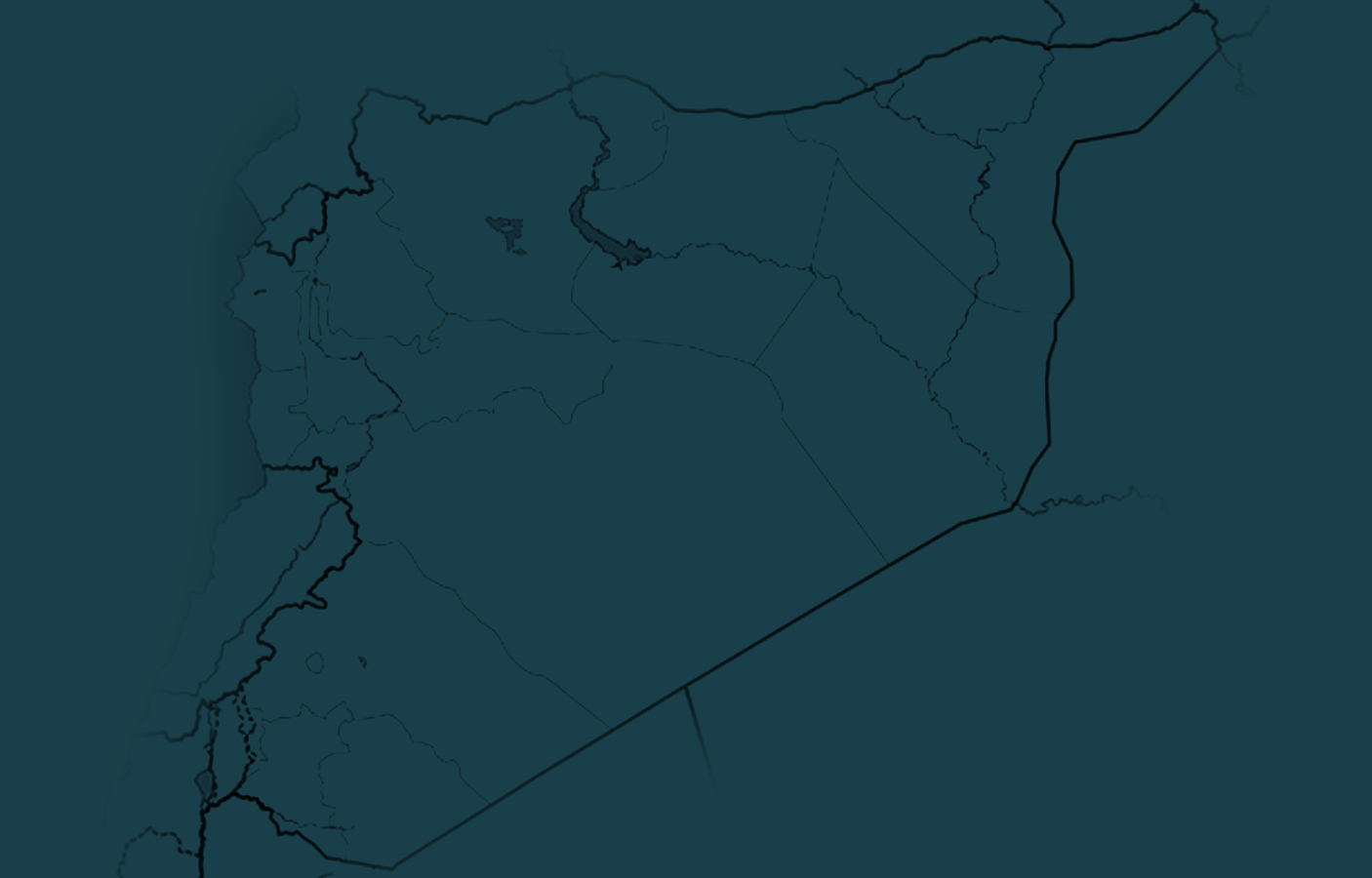
صفقةُ دمشقَ الموبُوءَة
يفرض العرف المخابراتي العالمي، أن تنشأ التنظيمات السياسيّة المحلية والإقليمية والدوليّة، المحابية منها للأنظمة والمعارضة، في أحضان أجهزة الاستخبارات، في الدولة التي يتشكل فيها هذا التنظيم أو ذاك، وبصرف النظر فيما إذا كان تنظيم الدولة “الإسلاميّة” هو خلطة أمريكية أو إيرانية أو نتاجا دوليا، إلا أنّ هذا التنظيم سرعان ما أتيحت له الأرضية الخصبة ليكوّن لنفسه جغرافيا مترامية الأطراف، استهلّها بالانخلاع عن التنظيمات السابقة، وتشكيل نفسه ككيان جديد موازي لتنظيم قاعدة الجهاد العالمي الذي كان يتزعمه أسامة بن لادن ومن بعده أيمن الظاهري، فعمد هذا التنظيم إلى كسب الأرض، وأخذ العامة من الناس على حين غرّة، ليساير أحلام أصحاب التوجّهات الإسلاميّة، قبل استيقاظهم من هذا الحلم المتأكشن، المبنيّ على أساسين اثنين، يقود أولهما إلى الثاني، إذ يقوم الأساس الأول على شرعنة “الجِّهاد الإسلامي” تحت راية موحدة تقود إلى “خلافة على منهاج النّبوة”، وهذا ما تمكن التنظيم من تحقيقه، إلا أن التنظيم سرعان ما دخل في الأخطاء المتتالية التي أدت لنهاية حتمية لكيانه، فما يثير الجدل حقاً هو تصوير تنظيم الدولة “الإسلاميّة” لنفسه على أنّه الكابوس القادم من الشرق، والمتوزع في الأرض، والذي يطمح لأن يخلق الفوضى في كامل العالم، حتى يتمكن من إيجاد أرض معطاءة لنفسه في كلّ مكان، وكانت أولى هذه الأخطاء هي طرح التنظيم خريطته للعالم بلونها الأسود بسواد لباس أبي بكر البغدادي، وتقسيم العالم إلى ولايات تحت إمرته العالمية، بزعيم يخشى على نفسه الظهور، سوى في خطبة أولى حتى يعرف أتباعه “خليفتهم”، وهذه مسلّمة في نظام الحكم الإسلامي، فتحوّل التنظيم بذلك إلى كابوس مرعب للعالم، إذ ما الذي يمكن أن تحقّقه “دولة” تهدّد العالم المحيط بها، وفي الوقت ذاته مهدّدة من كلّ العالم؟! وأول المهدّدين لها هي أنظمة الدول التي بنى التنظيم فيها نفسه ألا وهما سوريا والعراق.
الحراك العسكري للتنظيم، وتشكيل نفسه كقوة عسكرية كبيرة، عمودها الفقري الرئيسي المفخّخات بأشكالها، وعمليات الانتقام المتتالية من كلّ خصومها، سواءً المحلّيين منهم أو الدوليين، دفع الدول الكبرى إلى التحرك السريع لإبعاد التنظيم بقوته هذه، وتحطيمه بشكل متتالٍ على الأرض الرئيسية التي “شرّع” فيها حكمه، إذ أيقن الخصوم مبكراً أنّ تحطيم “دولة الخلافة على منهاج النبوة”، في معقلها الرئيسي، هو أولى الدعائم التي يمكنهم إبعاد أنصاره عنه، بل وتقليصهم، وتحويلهم إلى شتات يؤدي بالكثير من عناصره إلى الاستسلام سواء إلى دولهم أو إلى خصومهم الفعليين على الأرض، وشاهد معظمنا أو جميعنا، كيف تحوّل التنظيم من قوَّة مسيطرة تفرض نفسها على أكثر من 300 ألف كلم مربع في سوريا والعراق، إلى تنظيم يحكم الآن جيوباً متفرقة.
التتالي الدرامي لسقوط “دولة الخلافة” التي أنشأها التنظيم، عمّم فكرة القتل والأسر والاختطاف والسبي، وجعل منها الثمن الأنسب، مع وضع نفسه في خانة، لا تحمّل عليه عواقب أفعاله دولياً، من خلال نأي جميع الأطراف السياسيّة والعسكرية والحقوقية عن توجيه دعوة له لتحكيم العقل ومراعاة حقوق الإنسان أو تحميله مسؤولية أفعاله، وتهديده بمحاكمة دولية، وضع الخيار العسكري، كآخر العلاج، بعد تعذّر الوقاية منه، نتيجة إفساح دول وأنظمة بعينها، المجال أمام هذا التنظيم لتوسعة نفوذه بشكل كبير وسريع، متخذاً من الجميع خصوماً له على الساحة، وفي الوقت ذاته دفع بعض الأطراف على الساحة السوريّة بشكل خاص، إلى استغلال وضعه العسكري المتراجع، واتخاذه حليفاً لدوداً غير معلن، من خلال تمرير الصفقات عبره، لتتبلور على الجغرافيا السورية، فتحول تنظيم الدولة “الإسلاميّة”، إلى لعبة بيد هذه الأطراف، وفي الوقت عينه خصماً يجب القضاء عليه.
النظام السوري عمد من خلال إعلامه الهزيل، إلى ربط جميع التشكيلات العسكرية السورية بهذا التنظيم، معتمداً على فكرة هذه التشكيلات الخاطئة باتخاذ التنظيم “أخوة في المنهج”، وعزوف بعض التشكيلات وخصوصاً القوقازية والآسيوية منها مع بعض التشكيلات المحلية عن قتاله – رغم تحالف الأخيرة مع فصائل المعارضة السورية- إضافة لضخ النظام السوري عبر إعلامه والإعلام الموالي له، إلى توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة، لإقناع العالم بقتاله لمجاميع إرهابية تفرض نفسها كقوة ثورية، اكتفت على إثرها الجهات الإعلامية والحقوقية المحلية بدفع التهمة عنها، عبر تسخيف القضية، ومحورتها بشكل مقتضب، من خلال بثّ صور أطفال أو مواطنات في المجازر التي يرتكبها النظام، وتحويل قضية الإرهاب إلى قضية إنسانية، وهذا ما لم يلامس العقل الغربي، من خلال الدفاع الموازي للجهات المحلية الحقوقية منها والإعلامية عن تنظيمات كجبهة النصرة بتسمياتها المتلاحقة والمقاتلين الأجانب على الأرض السورية، وتصديرها بمنطق لم يتمكن من دحض تهم النظام بشكل كامل، فيما استخدمت روسيا التنظيم كمهدّد للنظام، الذي تحاول روسيا جاهدة، في إظهاره بشكل أو بآخر على أنه النظام غير القادر بدون روسيا على مجابهة هذا التنظيم ذي القوة الضاربة المتهالكة.
هذا التهالك قاد التنظيم إلى خسارة تواجده المعنويّ الأهمّ في جنوب العاصمة السورية دمشق، بعد سلسلة عمليات عسكرية امتدت لشهر كامل، منذ بدء جيش النظام السوري مع الفصائل الفلسطينية الرديفة وقوات الدفاع الوطني، في الـ 19 من أيار 2018، عمليتهم العسكرية ضدّ التنظيم الذي انقلب على الاتفاق، أشرف عليه جنرالات روس، بغياب تام للتواجد الإيراني وأتباعه من حزب الله والفصائل الشيعية العاملة تحت إمرة هذه القوات، لتجري صفقة بين ليلة وضحاها وسط تعمّد النظام والروس لتغييب الإعلام، بل تعدّى الأمر من هذا الإعلام إلى خلق تمويه وضبابية حول التوصل لاتفاق بين التنظيم والنظام والروس، حيث جرى خروج المئات من عناصر التنظيم في صفقة كاملة السرّية، كشفها متتبّعون فلسطينيون من سكان الجنوب الدمشقيّ، عبر أشرطة مصورة، كذّبت إعلام النظام السوري، وأظهرت قافلة التنظيم وهي تخرج نحو وجهتها الرئيسية في البادية السورية، لتنشقّ القافلة في منتصف الطريق إلى وجهتين رئيسيتين كانت أولاها نحو إدلب وهي تحمل أطفال ونساء من عوائل التنظيم، فيما تابع المقاتلون طريقهم نحو بادية حمص، وسرعان ما اتجهت مجموعات منهم نحو أطراف بادية السويداء في محاولة منهم للوصول إلى القطاع الغربي من محافظة درعا، حيث يتواجد جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم الدولة “الإسلامية”، ليسارع التنظيم إلى الانتقام من جيش النظام والحلفاء الإيرانيين بعد ساعات من تنفيذ الصفقة، من خلال شنّ هجوم عنيف على أقصى بادية تدمر الشمالية الشرقية، موقعاً قتلى وجرحى، تبعه هجوم من عناصر التنظيم القادمين من جنوب دمشق في الميادين، بإسناد من عناصر التنظيم السابقين في بادية دير الزور، ليوقعوا عشرات القتلى والجرحى ويتمكنوا من أسر العشرات، وسط تكتم على حيثيات الهجوم من قبل إعلام النظام خوفاً من كسر “انتصار” جنوب العاصمة الذي يقوده الروس في منطقة كانت إيران ترمي بعيونها إليها، ويشاع في عرف أهل الجنوب الدمشقي، أنها تتبع لمنطقة حرم المقامين -مقام السيدة سكينة في داريا بغرب دمشق ومقام السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي.
الدفع نحو البادية وتأخير تنفيذ الاتفاق، لم يكن بالأمر العادي، فروسيا تدفع اليوم إيران والقوى العاملة تحت رايتها، إلى مواجهة حتمية، ستقود بشكل حتمي إلى قتال على طريق الخامنئي – البغدادي – نصر الله، وهذا ليس بالأمر العابر، بل هو قرار روسي صُرِّح عنه من قبل الجنرالات القائمين على اتفاق ريف دمشق الجنوبي، والذين صرحوا علانية، أنه سيتجه حزب الله والإيرانيين إلى غرب نهر الفرات، لمواجهة تنظيم الدولة “الإسلامية”، الذي ينشط منذ قرابة الثلاثة أشهر في الداخل السوري، بعد انكسار وَضَعه في آخر قائمة المتنفذين على الجغرافية السورية بسيطرة على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي السورية، بشكل غير متصل من حيث مناطق السيطرة، في رسالة روسية إلى إسرائيل، تبعها تصريح من القيادة الروسية بوجوب انسحاب الميليشيات الأجنبية من سوريا، وتزامن مع هذا الدفع نحو غرب الفرات، رفض روسي لطلب مقاتلي التنظيم المغادرة إلى غرب درعا حيث المناطق التي يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد التابع لروسيا، في عملية روسية لخفض مستوى العمليات القتالية، ومنع إغناء هذا الجيش التابع للتنظيم من زيادة عناصره بصفقة قد تنهك الروس والنظام في حرب قادمة في غرب درعا، وخصوصاً أنّ حدود جيش خالد بن الوليد الغربية متاخم لمناطق خطّ الوجود الإسرائيلي في الجولان السوري، وهذا ما يلاقي بين هدف إبعاد الإيرانيين وحزب الله عن معركة حدود سوريا مع جولانها الخاضع للإسرائيليين، وبين منع التنظيم من الوصول إلى هذه الحدود بالذات، لتتبلور بذلك اللعبة السورية التي تقاد بخطوات مدروسة بشكل كبير، تحاول خلالها روسيا استرضاء القيادة الإسرائيلية، بإبعاد الخطر عنها، وبالأخص بعد تصاعد الضربات الإسرائيلية في الشهرين الأخيرين ضد حزب الله والإيرانيين على الأراضي السورية.
الخيار الروسي جرى فرضه على النظام، الذي تململ في تصريحاته تجاه الوجود الإيراني، إلا أن صوابية الموقف الروسي لحدّ كبير، في اتخاذ الأتراك حليفاً من بعد قطيعة وتوتر، لم يكن إلا رغبة روسية – تركية في إزاحة إيران عن العملية السياسية والعسكرية في سوريا، فالروس أدركوا مبكراً مدى أهمية الدور التركي في وضع أوزار الحرب، مستفيدين من التجربة التركية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في أواخر العام 2014 ومطلع العام 2015، حين كانت الأحداث العسكرية دائرة في كوباني، إذ أجبرت تركيا حينها على سد حدودها بشكل كبير أمام تنظيم الدولة “الإسلامية” الذي سرعان ما تحوّل إلى الداخل السوري لتغذية نفسه، عبر تشكيل وحدات جديدة في جيشه، تحت مسمى “أشبال الخلافة”، والتي دخلت إلى المعارك بعناصر من الأطفال والقاصرين، ممن جرى غسل أدمغتهم بحلم “الخلافة الإسلامية”، وهذا ما حول التنظيم اليوم بعد خروجه بصفقة سرية مع النظام وروسيا، إلى مهدد لطريق طهران – بيروت، أو خط “المقاومة الإسلامية” ضد إسرائيل.
إبعاد روسيا للإيرانيين عن خريطة المفاوضات وصفقات تغيير الخريطة السكانية في سوريا، بعد أن كانت حكراً عليها، وبعد أن أفرغ ريف دمشق من المقاتلين ما قبل الغوطة الشرقية – وهنا نتحدث عن القلمون وسهل الزبداني- لم يكن إلا اتحاداً مبطناً مع النية الأمريكية، لعملية عسكرية تبدأها الأخيرة من التنف، لقطع طريق طهران – بيروت وقطع الصلة البرية المباشرة بين الدولة المقادة من الخامنئي وحسن روحاني وبين أتباعهم في الضاحية الجنوبية وعموم لبنان، وهذا العمل العسكري يحتاج لمبرر ودافع، فأول الدّافِعَين هو تحريك الفصائل التي جرى تجهيزها في منطقة التنف من قبل التحالف الدولي، والتي سيكون دافعها هي الأخرى، قتال تنظيم “الدولة الإسلامية” على طول الشرط الحدود السوري – العراقي، وهو ما سيلامس الهدف المبطن، ألا وهو قطع طريق طهران – بيروت البري، والذي يعمل التنظيم منذ ما بعد البوكمال، على تنفيذ عمليات على هذا الطريق، الذي قاد قاسم سليماني معارك استكمال فتحه عند البوكمال قبل أشهر.
المواجهة الجديدة مع الإيرانيين، ستكون حرباً بمقاس أكبر، ستضطر فيها إيران إلى استنزاف نفسها، وإلى التأثير على داخلها المتخبّط بعد انتفاضة مواطنين ضدّها، وحصر إيران مع الميليشيات الإيرانية واللبنانية والأفغانية والعراقية، في خيار القتال على هذا الطريق، قد يقودها لخيار، ونهاية أشبه بنهاية تنظيم الدولة “الإسلامية”، من حيث الانتهاء عسكرياً والبقاء فكرياً، فالخصمان اللذان سيشعلان فتيل حرب الطريق الاستراتيجية هذه في غرب الفرات، قد يشهدان نهاية بطريقة واحدة، فالعنف الإيراني والغلو في سفك الدم، قد ينتهي يوماً إلى تشكيل تنظيم أشبه بتنظيم الدولة “الإسلامية”، ولكن بمواد خام تتبع للطائفة الشيعية.





