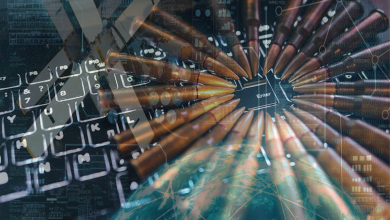تركيا من “صفر مشاكل” إلى مشكلة عالمية
مقدمة
من الملفت للنظر أن التركيز على الأزمة السورية بدأ يتراجع، بعد أن كانت تتصدر نشرات الأخبار، وتأخذ حيزاً واسعاً في النقاشات؛ وجداول الأعمال، إن كان على المستوى المحلي أو العالمي، لتتجه الأنظار إلى أماكن جديدة وبؤر ساخنة تحتدم فيها الصراعات، كالتوتر في شرق المتوسط، وليبيا، وناغورني قره باخ، التي يجمعها قاسم مشترك واحد هو تركيا العدالة والتنمية.
حاولت تركيا أن تكون قوة لا يمكن التغاضي عن دورها في الحلول المحتملة للعديد من الأزمات التي نشأت في دول المنطقة، حيث قامت بالكثير من المغامرات غير محسومة النتائج؛ إضافة إلى إحداثها لتغييرات واضحة في سياستها الخارجية، وانتقلت من مبدأ “صفر مشاكل” مع الجوار الى تعاظم في المشاكل، حتى بات اسمها واسم رئيسها يتردد في كل شاردة وواردة في المنطقة، بمناسبة أو من دونها.
دور تركيا الاستراتيجي
يظن الكثيرون أن تركيا العدالة والتنمية اليوم مازالت تحافظ على مكانتها الاستراتيجية بسبب موقعها الجيوسياسي المهم للسياسة العالمية، حيث كانت تُعَدّ سابقاً إحدى الركائز المهمة التي يعتمد عليها النظام العالمي والقوى المهيمنة، بحكم هذا الموقع، ووجودها في حلف الناتو. وكان الاعتقاد السائد أيضاً هو اعتبار تركيا، كإسرائيل، من الثوابت المهمة التي لا يمكن إهمالها، أو غض الطرف عنها من قبل القوى العالمية، ولكن هذا الدور قد تراجع لأسباب عديدة، نذكر منها:
- أثبتت التدخلات العسكرية للولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة خلال العقدين الماضيين؛ نُدرة الاعتماد على القواعد العسكرية الأمريكية، وقاعدة حلف الناتو، المتواجدتين في تركيا، خاصة بعد منع الأتراك للأمريكان من استخدام قاعدة أنجرليك في الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة على العراق عام 2003. وبالتالي بات بمقدرة الولايات المتحدة عدم إعطاء ذاك الوزن النوعي للحليف التركي في المنطقة؛ خاصة في ظل توفر بدائل لها في المنطقة.
- تبنّت حكومة العدالة والتنمية سياسة الانفتاح الاقتصادي أمام الرأسمال العالمي؛ خلال العقد الأول من حكمها إلا أنها بدأت لاحقاً بالانطواء، ومحاولات تشديد الإجراءات أمام دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتضييق الخناق على تلك القائمة في الداخل، من خلال اعتماد سياسة رأس المال البديل؛ أو ما يسمّى بـ “الرأس المال الأخضر”؛ أي رأسمال العدالة والتنمية.
- الابتعاد عن القيم التي يتبناها حلف الناتو، ومبادئ الاتحاد الأوروبي، والتمسك بالعقيدة الراديكالية، وتبنّي مشروع توسعي لإحياء “أمجاد” الدولة العثمانية، وفق أهداف وسياسة “العثمانية الجديدة”.
- الانحراف عن المسار الذي حددته القوى العالمية لوصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا، بسبب غطرسة رئيسها، ومحاولاته في التحرر، أو التملص من التزاماته حيال تلك القوى.
- تراكم المشاكل الداخلية منذ بدايات نشوء الجمهورية التركية؛ وتفاقمها في عهد حكومة العدالة والتنمية.
التحول من سياسة “صفر مشاكل” إلى تبني “العثمانية الجديدة”
مارست حكومة العدالة والتنمية سياسة “صفر مشاكل” في سبيل بناء علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط، إلا إن تبنيها لمشروع “العثمانية الجديدة”، الذي يتمحور حول فكرة الوصول إلى أغلب المناطق التي كانت تحت سيطرة العثمانيين سابقاً، دفعها إلى التدخل في شؤون الكثير من الدول، مستفيدة من الفوضى التي ظهرت مع ثورات “الربيع العربي” إقليمياً، ومشروع الشرق الأوسط الكبير عالمياً، واعتبرتهما فرصة لاستعادة تركيا ما خسرته في نهاية الحرب العالمية الأولى، وفي الاتفاقيات التي تلتها.
لكنّ وجود قوى رادعة لهذه السياسات التوسعية، أدخلت تركيا في دوّامةٍ كبيرة وتناقضاتٍ خطيرة للغاية؛ الأمر الذي أدّى إلى خسارتها للعديد من الدول الحليفة لها والتي تجمعها بهم أُطر عالمية مثل مظلة الناتو، وبدأت تتشكل أحلاف جديدة على خلفية هذه التطورات. فتركيا التي كانت تربطها علاقات قوية مع كثير من الدول الهامة إقليمياً وعالمياً، باتت معزولةً الآن، وبقيت تحركاتها محصورةً ضمن إطار الجماعات المسلحة الراديكالية، مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة والقاعدة والإخوان المسلمين، ودولٍ راعية لها مثل قطر. هذه التحركات ضمن هذا المحور، جعلت من تركيا مركزاً يستقطب قوى الإرهاب العالمي والإقليمي، والتي باتت تشكل مشكلة دولية، يبذل العالم بأسره جهوداً كبرى لمحاربتها. ومن هنا فإنّ تركيا التي كانت تنادي بسياسة “صفر مشاكل”، أصبحت هي المشكلة بحد ذاتها، نظراً لارتباطها الجليّ والوثيق مع الإرهاب العالمي.
اللعب على الحبال في السياسة الخارجية التركية
لم تبلغ أيّ من الحكومات التي تعاقبت على تركيا، درجة المراوغة واللعب على الحبال؛ التي بلغتها حكومة العدالة والتنمية، فقد استطاعت هذه الحكومة اللعب على التناقضات العالمية والإقليمية وحتى الداخلية. ولكن ما هو باد للعيان أن الحركات البهلوانية هذه أصبحت تضيّق الخناق عليها نفسها، لأنه في مثل هذه الظروف أو ما تسمى “بمرحلة الازمات”، يتعين على كل طرف من الأطراف المتصارعة تحديد هوية من يعتبره “عدواً” بشكل واضح. فعلى سبيل المثال، تعتبر إسرائيل إيران عدوّاً لدوداً لها، وبالتالي لم يعد بإمكان تركيا اللعب في هذه المساحة بين “العدوّين”، وذلك لصعوبة أن تكون في تحالفٍ إقليميّ مع إيران ومع إسرائيل في الوقت ذاته؛ وعليه، فإنّ على تركيا أن تحدّد الطرف الذي يكون بالنسبة لها على جانبٍ من الأهمية، وتعزّز علاقاتها معه، لأنّ احتدام الصراعات وزيادة حدّة التناقضات في المنطقة، لم يعد يسمح لتركيا بالاستمرار في سياستها التي كانت تتمثل في اللعب على عدّة حبال في آنٍ واحد وبالتالي فان تركيا باتت في مفترق طرق.
تركيا وصراع الهيمنة
منذ ما يقارب قرناً من الزمن، تمّ رسم حدود دول المنطقة من خلال اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، وقد تم تطبيق بعض بنود هذه الاتفاقية من الناحية العملية في معاهدة لوزان عام 1923، وتم خلق نوع من الوفاق والتوازنات بين هذه الدول، إن كان برضاهم أو أنهم اضطروا للمثول لها. ولكن مع دخول فكرة إعادة رسم الخرائط السياسية للمنطقة وفق المشاريع اللاحقة، بدأت تركيا بمحاولة الاستفادة من التوترات، لإحياء أحلامها التوسعية التي كانت مؤجلة.
تتصارع في منطقة الشرق الأوسط ثلاث دول إقليمية للوصول إلى الهيمنة، وهي إيران وإسرائيل وتركيا، تستخدم كل منها أدواتها لتصبح القوة الإقليمية الأولى، يحسب لها حساب في المخططات المستقبلية.
فإيران، وعن طريق سعيها في بناء هلالها الشيعي، بدأت بتضييق الخناق على مصالح الكثير من الدول، إن كانت مصالح دول المنطقة، أم مصالح القوى الدولية كالولايات المتحدة وغيرها.
أما إسرائيل فهي تُعَدّ خطاً أحمر بالنسبة إلى النظام العالمي، وإحدى الثوابت التي يمكن أن تخوض القوى المهيمنة الكبرى حرباً عالمية ثالثة من أجلها ومن أجل حماية مصالحها.
إن اتفاقية “ابراهيم”[1] جاءت لتفعيل الدور الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وتعزيزه كقوة مهيمنة، من خلال تطبيع العلاقات مع الدول العربية، ولتسحب البساط من تحت أرجل الدولة التركية، التي كانت تظهر نفسها كحليف مهم لإسرائيل من ناحية، وبأبوّتها لفلسطين وحركة حماس من ناحية أخرى. حيث سيتم سد الكثير من الثغرات التي كانت تُستغل من قبل إيران وتركيا في هذا السياق، والبدء بالسير نحو فرض الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة كدولة رائدة تقود الشرق الأوسط، وتكون محوراً أساسياً في القضايا العالمية المتصلة بالمنطقة.
أما الدولة الإقليمية الثالثة فهي تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية، وقد عبّرت عن نواياها في أكثر من مناسبة لبلوغ مستوى “القوة الإقليمية المهيمنة”، والوصول إلى مصاف “قوة عالمية”، وذلك من خلال فكرة سياسة “العثمانية الجديدة”، ومحاولة قيادة عالم الإسلام السني، فقد استغل أردوغان الفوضى القائمة في المنطقة في سبيل تحقيق هذه الأهداف، معتمداً على بعض الأدوات، منها إنشاء “جيش انكشاري” من المرتزقة، والاعتماد على جماعات مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب العالمية، مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، واستخدامها وسيلة لتمهيد الطريق أمام جيشه للدخول إلى المناطق التي كانت تطمح في الوصول إليها، وإنشاء قواعد عسكرية فيها، ظنّاً منها أنّ كثرة امتلاك تركيا للقواعد العسكرية في المنطقة ستجعل منها قوةً عظمى، كما هو حال بالنسبة للولايات المتحدة، فهو يسعى من خلال سياساته التّدخلية هذه إلى التشبه بالولايات المتحدة وليس بسواها.
ومن هنا فقد مارست الدولة التركية سياسة الضغوطات القصوى في المنطقة؛ لبلوغ أهدافها التي تطمح إلى تحقيقها، وذلك بجرّهم الى ساحتها لاجبارهم على فتح باب المفاوضات معها، وفرض مطاليبها عليهم، ولكن ما هو باد للعيان أن النتائج كانت عكسية تماماً، حيث أن القوى الدولية بالمقابل مارست سياسة غض الطرف أمام تماديها في المنطقة، إلى أن أصبحت تهدد مصالح الكثير من هذه الدول، وبالتالي أضحت مشكلة عالمية بعد أن باءت سياستها بالفشل، والسحر بدأ ينقلب على الساحر، فالأوضاع الاقتصادية باتت في الحضيض؛ فضلاً عن ظهور ملامح تشّكل جبهات دولية مناهضة لتوجهات تركيا هذه، ومن الضغوطات تدخلها في شرقي المتوسط، وذلك في سبيل إيجاد موطئ قدم لها في تلك المنطقة، بغية الحصول على غاز حوض البحر المتوسط. لكنّ ذلك أضرّ بمصالح الكثير من الدول المهمة، كالاتحاد الأوربي، ومصر، ودول الخليج العربي، وكانت النتيجة إنشاء تحالف بين هذه الدول، للحدّ من التدخلات التركية، وأيضاً يُعد شراء منظومة الصواريخ الروسية S 400 أحد أوجه سياسة الضغوطات القصوى التي تمارسها تركيا، فالجيش التركي مسلّح بأكمله بسلاح الناتو، وإقدام الحكومة التركية على شراء سلاح، لا يمكن استعماله إلا في حال تغيير المنظومة العسكرية للجيش بمنظومة عسكرية روسية، وهذا يحمل عدّة تفسيرات، منها أن يكون ذلك أداة ضغط على الناتو نفسه لإبداء مواقف أكثر قوة تجاه حليفها في مشاكلها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
مستقبل تركيا في حلف الناتو
تستغلّ تركيا اليوم، كما استغلت في السابق، وجودها ضمن حلف الناتو لتمارس أقصى أنواع الضغط على الدول “الحليفة” لها، لتحقيق أهدافها، حتى وصل بها الأمر حدّ المبالغة والتمادي، وباتت تطالب بمساعدة الناتو في جميع ساحات الصراع التي تشعلها، تهرّباً من أزماتها الداخلية التي تعيشها. حيث أدّى ذلك إلى طرح دول فاعلة في الحلف نقاشاً جديداً حول مدى أهمية حلف الناتو، أو الإشارة إلى موته السريري، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
لقد بات حلف الناتو يعاني من شرخٍ واضحٍ في هيكليته، ولذلك أصبح لزاماً عليه، التخلص من عبء الكثير من الدول، ومن الممكن أن يتحقق ذلك من خلال بناء هيكلية دفاعية جديدة، وذلك نظراً للتغير الذي طرأ على مفهوم الدول “الحليفة” في هذه المرحلة.
فنحن نجد أنّ كثيراً من الدول هي حليفة للقوى المهيمنة عالمياً، لكنها في الوقت نفسه خارج إطار الناتو، كما نجد أنّ دولاً تعتبر “حليفاً” في الناتو باتت تحلّق خارج السرب، كما هي الحال مع تركيا، لذلك ليس من المستبعد أن نشهد قيام تحالفٍ دفاعيٍّ جديد على مستوى العالم، وما يدلّل على هذا الاعتقاد هو تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر المُقال، حيث قال فيه: بأنّ الناتو لم يعد ذو فائدة، وأنّه من الضروري البحث عن هيكلية أشمل للدفاع، أو ما سمّاه بـ “الدفاع المعولم”.
والسؤال المهم هنا، هل ستكون تركيا “العدالة والتنمية” جزءاً من هذه الهيكلية؟
يبدو جليّاً أنّ تركيا التي ترزح تحت وطأة المشاكل الداخلية والخارجية، لا يمكنها أن تكون جزءاً من منظومة الدفاع العالمي الجديدة، نظراً لأنّ الجبهة التي ستشكّل قوة الدفاع العالمية، تتعارض توجهاتها مع أطماع تركيا التوسعية.
السيناريوهات المحتملة أمام تركيا
لقد فُتح المجال أمام تركيا لتتدخل في الكثير من المناطق الحساسة في العالم، وشكلت بذلك ضغطاً على مصالح الكثير من الدول، إلى أن أصبحت تركيّة أردوغان مشكلة عالمية لا بدّ من إيجاد حلّ لها، فما هي السيناريوهات التي يمكن أن تواجهها تركيا؟
- كان أمام تركيا إمكانية اختيار السهل الممتنع في هذه المرحلة، وهو العودة إلى الالتزام بقيم ومبادئ حلف الناتو، والوقوف إلى جانب القوى المهيمنة عالمياً، لكنّ يبدو أنّ ذلك لم يعد متاحاً لها الآن، بعد المغامرات التي قام بها أردوغان في الساحة السياسية الخارجية، لأن ذلك سيفرض على تركيا العدالة والتنمية حل الكثير من المشاكل العالقة، الداخلية والخارجية. ولكن حل أية مشكلة الآن بات مرتبطاً بانهيار النظام الذي بناه أردوغان، حيث بنى نظامه ليبقى في السلطة إلى الأبد في حكم تركيا، ونظّم كل شيء لتحقيق هذا الهدف، فقد غيّر دستور الدولة، ولم يترك المجال أمام الإصلاح أو الترميم، ما يعني أنه بنى جمهورية جديدة على أنقاض جمهورية أتاتورك العلمانية، ألا وهي جمهورية العدالة والتنمية، متّبعاً في تأسيس هذه الجمهورية سياسة حافة الهاوية، لدرجة أنه لم يترك أية إمكانيةً للرجوع خطوة إلى الوراء، لأنّ هذا التراجع سيكون محدّداً لمصيره بشكلٍ شخصي. وعليه فإن هذا الخيار أو الاحتمال أصبح في راهننا من أصعب الخيارات؛ لأنه سيكون محدداً لمصير أردوغان بشكل مباشر.
- الاحتمال الآخر الذي ينتظر تركيا هو المصير الذي واجهته ألمانيا؛ في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وذلك بسبب انجرار حكومة العدالة التنمية بشكل مفرط إلى الكثير من ساحات الحرب، ويحدثنا التاريخ كيف تمّ تحميل ألمانيا وزر الحرب وخسائرها، وهذا مصير محتمل قد تواجهه تركيا، بسبب توسيعها لنطاق ساحات المعارك في كثير من المناطق؛ إذ ليس من المستبعد أن تتفق كلّ الدول المتضررة من تدخلات تركيا المتهوّرة على تحميل وزر الصراعات التي أشعلتها تركيا في كلّ من سوريا والعراق وليبيا وقره باغ؛ إضافةً إلى تدخلها في منطقة المتوسط، وتثبيت حقيقة دعمها المباشر وغير المباشر للإرهاب العالمي.
- باتت تركيا تعيش حالة من العزلة المريبة، بعد أن أصبحت مشكلة عالمية تقريباً، وأصبحت تؤثّر سلباً على الكثير من المصالح الدولية، مما خلق جبهة واسعة من “أعداء” تركيا، وينعكس ذلك في توجه الإعلام العالمي ضد نظام أردوغان، وهذا يذكّرنا بمصير الحكام المتغطرسين في المنطقة. وعليه، فإنّه من المحتمل أن يتمّ “سرينة” تركيا، من خلال إشعال صراع داخلي فيها، كما حصل في سوريا، نظراً لأنّ الظروف باتت مهيّئة لانفجار الداخل التركي بسبب ازدياد المشاكل الداخلية، والتي يمكننا عدّها على الشكل التالي:
- القضايا القومية للشعوب المضطهدة داخل تركيا، مثل القضية الكردية، وقضايا باقي المكونات العرقية التي تنكر الدولة هويتهم القومية.
- قضايا الديمقراطية والحريات في تركيا، القائمة أساساً على قمع الحريات والتضييق عليها، سواءً أكانت الحرية الدينية، أو حرية التعبير، أو حرية التفكير وغيرها، والتي وثقتها تقارير حقوقية عالمية، وهي القضية نفسها التي شكلت عقبةً أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي أيضاً. كما أن تركيا التي تستخدم الانتخابات كوسيلة للديمقراطية المزعومة، تلغي نتائج الانتخابات بكل بساطة عندما لا تكون هذه النتائج لصالحها، وهو ما حدث في إقالة رؤساء بلديات المدن الكردية من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.
- الفساد المالي والإداري، حيث يستفيد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم أكثر من غيرهم من الوظائف في الدولة، كما يتمثل هذا الفساد أيضاً في فصل الكثير من الموظفين من وظائفهم بذريعة ارتباطهم مع فتح الله غولن، أو علاقتهم بانقلاب 19 تموز.
- الوضع الذي آل إليه الجيش التركي؛ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وما أعقبه من زجّ الكثيرين من أفراده في السجون، فالجيش منقسم بشكل واضح بين التيار الذي يدعمه أردوغان، والتيار المتبنّي لثقافة الدولة العلمانية، أو التيار المحسوب على حلف الناتو.
- التدهور الاقتصادي، الذي يعتبر السبب الأهم في زيادة احتقان الشعوب ضد حكوماتها، حيث وصلت الليرة التركية، بحسب الخبراء الاقتصاديين، إلى أدنى مستوياتها منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم. وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي حتى باتت تركيا بيئة طاردة للاستثمار.
ختاماً.. من الواضح أن كل المؤشرات تشير إلى فشل سياسة حكومة العدالة والتنمية التركية في بلوغ أهدافها، فالضغوطات التي استخدمها أردوغان جاءت بنتائج عكسية، وأهمها أن تركيا أصبحت بؤرة الإرهاب العالمي بشكل واضح، كما أن الأطراف الدولية المتضررة من سياسة تركيا في المنطقة وهي: اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل والسعودية والإمارات، قد بدأت بتشكيل أحلاف وجبهات مناهضة للسياسة التركية في المنطقة. كما أن فرصة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي باتت أمراً بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى؛ فضلاً عن فقدانها لثقة حليفتها الأبرز، الولايات المتحدة، بعد التوجه صوب روسيا التي لا يؤتمن جانبها.
إن سياسة تركيا الخارجية ونتائجها انعكست سلباً على الوضع الداخلي التركي، فالديمقراطية والحريات تسجل تدهوراً منقطع النظير في تاريخ الجمهورية، كما أن الليرة التركية تسجل تراجعاً يومياً، مما يزيد في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن التركي؛ الذي قد ينفذ صبره في أي وقت، وبالتالي فإن حكومة العدالة والتنمية باتت أمام مفترق طرق داخلياً وخارجياً.
[1] يجسد الاسم، ديانات الدول الثلاث المشاركة في الاتفاقية: “الإسلام (الإمارات)، اليهودية (إسرائيل)، المسيحية (الولايات المتحدة الأمريكية)، وهى الديانات السماوية الثلاث، أو المعروفة بالإبراهيمية نسبة إلى أبو الأنبياء النبي إبراهيم(ع).