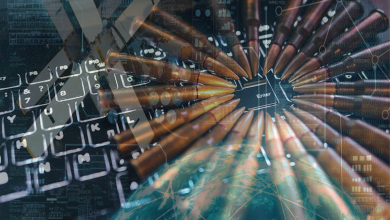الحرية بين الفوضى والتقييد
الموضوعة التي نتحرّى قرارتها موضوعة شائِكة، إن بسبب من تأريخها الموغل في القدم, وبسبب من التحوّلات التي طالتها تحت وطأة الزمن، غير بعيد عن تعاقب السلطات بأنماطها المختلفة، ناهيك عن أنّنا إذ نقف بمواضيع نظرية، كثيراً ما نتوهّم – ولوهلة – بأنّنا قد وضعنا يدنا على جمر الحقيقة، وأنّ المفاهيم التي نطرحها كالوطن أو الحب أو الحريّة أو الأمة هي ملك يميننا، بيد أنّنا إذ نضعها على المحك، نكتشف – غالباً – عجزنا عن الإحاطة بها، أو تقديم تعريف جامع مانع لها.
إنّنا إذ نقف بالحريّة – كموضوعة – على سبيل التمثيل، متحرّين، قد نرى لزاماً علينا أن نعود إلى جذرها اللغوي، سنقع على التحرير بمعنى الإفراد، كما جاء في كتاب الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، بيد أنّ الفيروز آبادي ذهب إلى أنّ تحرير المبحث هو تعيين له أو تعريفه، فيما رأى في مفهوم تحرير الكتاب تقويمه، أمّا تحرير الرقبة فتعني إعتاقها، وقد نذهب بالتحرير جهات معنى آخر هو الكتابة، كما أنّها ترد بمعنى الأرض اللينة، أو من العرب أشرافهم بالاتكاء إلى ما جاء في القاموس المحيط.
إذاً – وبعيداً عن دلالاتها الراهنة – فنحن أمام معانيّ شتى للمفردة، ما يجلو غناها بالإيحاءات والظلال والأفياء، وما طالها من تطوّر أو تحوير، إلاّ إذا أخذنا تحرير الرقبة بمعنى إعتاقها كمقاربة أولية لها، ولاشك أنّ التحوّلات التي أتينا عليها طالت المعنى – على مرّ الزمن – لتصل به إلى مفهوم الحريّة الحاليّ، بما هو – في الانعكاس العمليّ – الفرد الحرّ غير الخاضع – إن في سلوكه أو في رؤاه – لأحدٍ فرداً كان أو عائلة أو قبيلة أو مذهباً أو طائفة أو مُؤسّسة سلطوية في مجالات الحياة كافة، كتماه أو تطبيق للفلسفة الليبرالية، التي تصدرّت فلسفة الأنوار الأوروبية، وبما يؤكّد أنّ اللغة ذاتها حدث في التأريخ؛ أي أنّها زمنية، ناهيك عن كونها فعل يتمّ في العقل.
لقد كانت المرحلة الأموية (نسبة إلى الأم)، تلك التي كانت المرأة فيها مُتحصلة على حقوقها، ربّما لأنّها أصل النشوء ووعاؤه، ناهيك عن قيامها بالجمع والالتقاط، والبحث عن الجذور والحشرات والديدان إلى جانب الرجل يداً بيد، نقول بأنّها – أي تلك المرحلة – كانت مرحلة ذهبية في الحرية للجميع رجالاً ونساءً، إذ لم يكن الاسترقاق معروفاً، وكانت المجموعات البشرية بحاجة إلى جهد أفرادها للتحصّل على حاجتهم إلى الطعام، وللتدليل على ما تقدّمَ سنذكّر بأنّ نسب الابن أو الابنة كان يتحدّد بأمهما لا بأبيهما، ذلك أنّ الانتساب للأب لم يكُ دقيقاً، في مجتمع ما كان قد عرف الزواج الأحادي بعد، وفوق هذا وذاك – أو من باب التأكيد على ما سلف – سنجد غير آلهة مُؤنثة إلى جانب الآلهة الذكورية.
كان المجتمع يحبو ويتغيّر على نحو بطيء، شبيه بسباق السلحفاة, ليعيش طفولته الطويلة ربّما، بيد أنّه – على بطئه – كان أكثر عدلاً وإنصافاً للطرفين، إذ كانت قيمتهما تتحدّد بنسبة ما يقدّمه كلّ منهما من إنتاج، في مشاعة يشترك أطرافها في الحقوق والواجبات؛ أي أنّه كان مُنتصراً للحرية، إلاّ أنّ التكاثر والحاجة والتطوّر قادتا الإنسان البدائيّ إلى الصيد، ليتقدّم الرجل قليلاً في مجال الحقوق، لكن من غير أن تنتقص مكانة المرأة كثيراً، ذلك أنّها ظلّت تقوم بالجمع والالتقاط؛ أي تسهم في التحصّل على طعام البشرية إذ ذاك.
إنّ الصيد يتطلّب مُراقبة طويلة للطرائد، ومعرفة عاداتها، ككيفيّة الاقتراب منها بعكس اتجاه الريح، ربّما بسبب قوة حاسة السمع عندها، وتدبّر الأداة المناسبة لصيدها، متى ترد الماء مثلاُ؟! نقول بأنّ تلك المُراقبة قادت الإنسان إلى أنّ بعضها قابل للتدجين، فدجّنها، هكذا ظهرت المجتمعات الرعوية، بيد أنّ المرأة لم تفقد قيمتها كلية كما أسلفنا، وذلك لأنّها لم تركن إلى كهفها أو خيمتها بعد، بل ظلت تنتج جزءاً لا يستهان به من حاجة المجموعات البشريّة إلى الغذاء.
لكنّ الانتقال من الصيد إلى مهنة تربية الحيوان لم يتحقّق بين يوم وليلة، بل تطلّب وقتاً طويلاً من الإنسان، ليتوصّل – من ثمّ – إلى تدجين حيوانات كثيرة، إلاّ أنّ حياته لم تتبدّل كثيراً، ربّما لأنّه ظلّ بلا مأوى ثابت، إذ ظلّ التنقل إلى المراعي ديدنه، لقد كان – من قبل – ينام في الكهوف والمغاور أو فوق الأشجار خوف الحيوانات المُفترسة، لكنّه مع الرعي صار ينام في خيمة، بيد أنّ حاجاته أضحت متحقّقة بدرجة أكبر!
أمّا الانقلاب الأكثر أهمية في حياة الإنسان، ذاك الذي عرض حياته كلّها إلى تغيير جوهريّ، تمثّل في اكتشافه للزراعة، لقد بدا المشهد – وبشيء من التبسيط – بالدهشة فالملاحظة، ذلك أنّ ثماراً سقطت من يده أثناء جمعها بجانب مصدر مائيّ، ليراها بعد أيام قد نمت، فكانت الدهشة بداية الطريق إلى المعرفة على حدّ تعبير سقراط، لينتقل من الدهشة إلى طرح الأسئلة عمّا إذا كان الموضوع خاضعا للمصادفة، أم أنّه فعل بشريّ قام هو به عن غير قصد، وكان للفضول المعرفيّ والتجريب دوره الحاسم في الجواب على هذه الأسئلة.
مع الزراعة كثورة أولى في تأريخ البشريّة – إذاً – عرف الإنسان قيمة الأرض، وبإدراكه لقيمتها ظهرت الملكية الخاصة، ذلك أنّه بنى كوخاً بجانب القطعة التي تخصّه، لتظهر – من ثمّ – القرى الأولى على سطح البسيطة، وليغادر الإنسان حياة التنقل بشكل نهائيّ، ناهيك عن أنّه – أي الإنسان تحصّل ولأول مرة على فائض من الانتاج، لتتطور التجارة الجنينية التي كانت بين الصياد – أو الراعي – وجامع الثمار بالمقايضة، ومعها – أي مع الزراعة – ظهر تقسيم العمل، إذ عرف الناس النجار حتى يصنع للكوى الأبواب والنوافذ – على سبيل التمثيل لا الحصر – والحدادة لصنع غير أداة، ما أسهم في انتقال الإنسان إلى تصنيع أدوات أكثر تعقيداً، وبالطبع ما كان هذا كله بعيداً عن اكتشاف النار، التي نقلته من العصر الحجريّ الحديث إلى عصر المعادن، كما لم تكن الزراعة بعيدة عن الانتقال من المشاعة إلى الزواج الأحاديّ، الذي كان محتكماً لبعده الاقتصادي، ذاك الذي يحافظ على المال داخل الأسرة، بحسب ما جاء عليه أنجلز في ” أصل العائلة والملكية والدولة “، مع الزراعة عرف الإنسان المجتمع الطبقيّ، إذ انتقل من المشاعية إلى النمط العبوديّ!
كانت بعض القرى قد نمت – فيما بعد – بسبب من هيمنتها على طرق المواصلات ” تدمر، مثالاً ” أو لسبب دينيّ ” مكة ” أو لوقوعها على شاطئ بحر ما ” صور ” لتتحوّل إلى مدن، وليتعرّف الإنسان على أول أنماط الحكم، مُمثّلاً بمملكة المدينة ” أور، أو لاكاش السومريّتين “0
إنّ العبوديّة اشتراط غير إنسانيّ، لذلك ثار الإنسان عليها ” ثورة سبارتاكوس ضدّ الأسياد في الامبراطوريّة الرومانية ” هكذا وبنضال دؤوب تحصّل أسرى الحروب على حريّتهم، لكنّها عن حريّة شكليّة، إذ أن انتقال الإنسان من العبوديّة إلى الإقطاع لم يلغ التراتبيّة الطبقيّة، هكذا – ربّما – فقد جزء من البشر حريتهم كما في العبوديّة، ليضحوا تحت رحمة عبودية العمل في التشكيلة الجديدة، هذا في ما يخصّ الرجل، كانت المرأة – هي الأخرى – قد فقدت قيمتها، واختفت خلف جدران إغراءات القمح كزوجة أو حبيبة أو محظية أو جارية أو أمة أو أمّ أو شقيقة، لتتسيّد التشكيلة البطريركية الأبويّة، التي تكون الكلمة الفصل فيها للرجل، ولانظننا مجافين الحقيقة إذا حكمنا بأنّ الحضارات – إذ راحت تغادر مملكة المدينة المحدودة بالأرض المحيطة بها، لتندرج في إمبراطوريات كبيرة – قامت على نظام القنانة، وأنّها حضارة اتكأت على القمح، هذا ما حدث في الصين الدافئة أو في جنوبي شرقي آسيا ” كمبوديا وتايلاند وميانمار.. إلخ ” أو في الهند أو في وادي السند ” باكستان اليوم “ أو في الهضبة الإيرانية أو في بلاد ما بين النهرين ” العراق وبلاد الشام بما فيه ساحل سورية الطبيعية ” أو في مصر القديمة أو في أفريقيا الشمالية وصولاً إلى المكسيك في أمريكا الوسطى؛ أي في قوس المناخ المعتدل، ثم راحت جموع البشر تنداح شمالاً أو جنوباً مع إيغالها في السيطرة على الطبيعة، ناهيك عن التزايد الكبير في أعدادهم، ولنا في اليونان مثال على مُجتمع تراتبيّ يضمّ العبيد إلى جانب السادة، أمّا الامبراطورية الرومانية فلقد تزايدت العبودية فيها، بسبب الحروب التي حولت الأسرى إلى عبيد كما أسلفنا.
هكذا – إذاً، ولأنّ الأشياء تعرف بأضدادها- عُرفت الحرية بالضدّ من العبودية تحت مُسمياتها المختلفة؛ أي أنّها راحت تقترب من اصطلاحها الراهن في أبعادها الاقتصادية والثقافية والسياسية، فهل تغيّر الحال في المجتمع الرأسمالي، الذي انتقل مركز الثقل الاقتصادي – فيه – من القرية إلى المدينة، ومن الزراعة إلى الصناعة، ليعدّه المُؤرخون الانقلاب الثاني في حياة البشرية بعد الزراعة؟!
في الظاهر ستبدو الإجابة أقرب إلى الإيجاب، إذ لم يعد العامل عبداً لربّ العمل كما في مُجتمع الإقطاع، ولكنّه في الحقيقة كان عبداً للعمل ذاته، باعتباره طريقاً للقمة الخبز الغميسة بعرقه؛ أيّ للحاجة كما في الإقطاع! هكذا سنضطر إلى الإقرار – ثانية – بأنّ الفترة الذهبيّة للحريّة كانت في التشكيلة القائمة على الجمع والالتقاط؛ أي في تشكيلة المشاعة الأولى.
قد يتهمنا أحدهم بالافتئات على مرحلة ما، أو تحميلها ما لا تحتمل، بيد أنّ هذه الورقة ليست ناجزة تماماً، ذلك أنّها لا تدّعي الإحاطة بالحقيقة كاملة، وأنّها تحتمل الخطأ تماماً كما تحتمل الصواب، وأنّ الحوار الجاد والمسؤول قد يُغنيها أو يُناقضها للوصول إلى تصوّر واضح عن المسألة موضوع البحث.
البورجوازية الأوروبية – إذاً – كطبقة صاعدة، على إثر الكشوفات الجغرافية، التي حملت الذهب إلى أوروبا، لتصرف قسماً منه على البحث العلميّ، وتضع اللبنة الأولى للانقلاب الصناعيّ، مُؤسّسة الدولة الوطنيّة على ترابها، ليس بالمفهوم الاقتصادي فقط، بل بمعنى مسألة الإنتاج المُشترك، وعلاقات الانتاج المُشتركة، هذا كله بعيداً عن المعنى الستاليني لمفهوم الوطن، وذلك لتحمي صناعتها من منافسة الدول الأخرى، من غير أن ننسى أنّها لم تكتف بعبيد العمل في بلادها، بل استعمرت غالبية أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بل وأمريكا الشمالية أيضاً، وفي مرحلة لاحقة اصطاد الأفاقون العبيد من أفريقيا لاسترقاقهم في حقول أمريكا غبّ تشكّل الولايات المتحدة الأمريكية.
ثمّ راح البحث في مناحيّ الحياة يطرح أفكاراً كثيرة، كان الكهنوت المسيحي يهيمن على اللوحة غير المشرقة له، لتظهر البروتستانية كثورة في وجه الكاثوليكية، التي وقعت في غير خطأ، حتى أنّها باعت رقائق الجنة لمن يستطيع الدفع، لكنّ التطوّر الأهم كان في الفكر الفلسفيّ، الذي لم يكتف بإغناء الفلسفة اليونانية، بل أضاف إليها تيارات مُهمة، وعلى الصعيد السياسيّ أطلت الديموقراطية والعلمانية على المشهد، وفصلت الدين عن الدولة، لتنتصر الشعوب – من ثمّ – للبرامج لا الشخوص، بعد أن تهاوت السلطة الملكية في فرنسا إثر ثورتها، بيد أنّنا سنكتفي – في هذه العجالة بالوقوف – بالتيار الليبرالي، ذلك التيار الذي يقوم على الفرد الحرّ في إطار القانون، بعد أن تحقّقَت له دوله الرفاه.
لقد اجتهد المفكّرون في رسم علاقة الحاكم بالمحكوم، ويحضرنا في هذا لوك وهوبز وروسو ومونتسكيو، لكن صيغة العقد الاجتماعيّ، تلك التي ارتبطت بروسو تسيّدت تلك العلاقة، التي تتلخّص بتنازل الجمهور عن جزء من حقوقه، مقابل أن يقدّم الحاكم له الأمان وسبل العيش الكريم.
وفي تحرّي العلاقة بين الحرية والفوضى، سنرى بأنّ هذه المقولة تقتصر- إلى حدّ كبير – على أنظمة العالم المُخلف، ربّما على سبيل التبرير للدكتاتوريات العريقة، التي حكمته طويلاً، تلك التي تذكرنا بعلاقة الراعي بالقطيع، المحتكمة إلى عصا الراعي المسيحيّة بحسب ميشيل فوكو، ثمّ أنّ غير نظام منها قد يكون من صنع الدوائر الامبريالية ذاتها، تلك الدكتاتوريات التي ستلجأ إلى التقييد بحجة أنّ الحرية تقود – بالضرورة – إلى الفوضى، وقد تروّج بأنّ درجة التطوّر في بلدانها قاصرة ولا تحتمل المّمارسة الديموقراطية، لهذا سيتفاجأ الجمهور العريض – المرّة تلو المرّة – بنتائج الاستفتاءات التي تقيمها السلطة بدل الانتخابات لغياب المنافسة، ذلك أنّها ستحقق أرقاماً خيالية تتاخم نسبة المائة بالمائة، هكذا – في ما نتوهم – سيختصر الحزبُ الشعبَ في تشكيلته، فيما يختصر الحاكم العالمثالثي الحزب – ذاته – في شخصه، ليتربع على قمّة الهرم السياسيّ بلا مُنازع أو مُنافس، وقد يذهب بعضهم إلى إرث دينيّ يغطي عورته، إرث أدرك الحاكم – منذ زمان موغل في القدم – أهميّته في توليف الرؤوس على مفهوم الطاعة العمياء، هكذا – إذاً – وبسبب من غياب الممارسة السياسية – أو انحسارها – سيُنهب المال العام، إذ يتسيّد الفساد المشهد في تراجيديّته، وستنمو الأرصدة المسروقة من قوت الناس في المصارف الخارجيّة نمواً خرافيّاً، وستتوقف عملية التنمية، فيما يتضخّم العجز في المديونية، ما يعني بالضرورة أعداداً متزايدة من العاطلين عن العمل، ناهيك عن انحسار في العمل السياسيّ كنا قد جئنا عليه في ما تقدّم من الكلام، بسبب الكلفة المرتفعة التي كان على القوى المعارضة أن تدفعها، إذ تهددتها السجون أو المنافي، من غير أن ننسى بأنّ البورجوازية العالمثالثية لم تلعب الدور الذي لعبته البورجوازية الأوروبية، ربّما لأنّها برجوازية طفيلية، أي بورجوازية كولونيالية ترتبط بالخارج، وإذاً فهي ستسهم في تهريب الأموال إلى الخارج، وتدرج مالها في صناعات خفيفة سريعة المردود، ربّما لأنّ رأس المال يظلّ جباناً بحسب ماركس.
ما الخواتيم التي ستوصلنا إليها المُقدمات المروّعة، التي أتينا عليها على مُستوى العالم الثالث!؟ وذلك لنتحصل على أجوبة تقارب ما حدث، إنّ في التقديم أو في المتن، سنذهب إلى أنّ الحرية ليس لها صفة الإطلاق بالاستناد إلى نسبية الأفكار، بل إنّها – أيّ الحرية – تتماهى بالمسؤولية؛ أي بالواجبات، لكنّها – بالمُقابل – تحيل إلى خانة الحقوق، وهذا يعني توقف حرية الأفراد عند الحريات العامة في حدود القانون، ثمّ إنّ الحرية مكفولة من الدساتير، والدساتير تحكم على مخالفيها بما يقترفونه من مخالفة لتلك القوانين المصانة بقضاء نزيه ومفصول عن السلطة التشريعية أو التنفيذية، ربّ قائل وماذا عن التجربة الاشتراكية!؟ لقد تجاهلتم فيلسوفين كبيرين من وزن ماركس وأنجلز، ونحّيتم لينين جانباً، غير أنّنا سنذهب إلى أنّ تجربة الاتحاد السوفياتي لا تختلف عن تجربة العالم المُختلف عموماً، نقصد في طبيعة التجربة، ذلك أنّ الحزب الشيوعيّ كان الوحيد الذي يعمل على الساحة، ما يذهب جهات ديكتاتوريّة الدولة إن جاز لنا التعبير، وكان نظام الاستخبارات الـ : ك جـ ب مُخيفاً للبشر والحجر والشجر، صحيح أنّ حقوق الطفل – مثلاً – قفز قفزات كبيرة إلى الأمام، وأعيد للمرأة بعض حقوقها، ولكن من قال بأّن المرأة يمكن أن تعمل في كل مكان، كأن تعمل في المناجم مثلاُ، في تجاهل للطبيعة الفيزيزلوجية لها!؟ لقد أنتج لينين في تطبيقه للماركسية اللينينة نظاماً شمولياً، احتذت به غير دولة من دول العالم الثالث، وأخذ شكله المرعب في ظلّ حكم ستالين، وصفّي عدد كبير من قيادات الحزب بعد انقسامه، حتى أنّ لجوء تروتسكي إلى المكسيك لم يعفه من دفع تكلفة معارضة البلاشفة!
ثمّ ماذا بعد!؟ سؤال سيطرح نفسه بإلحاح، وفي الجواب سنذهب إلى أنّ الحرية تقع في قلب الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بمواده الثلاثين، وأنّ القوانين تمنع من الشطط فيها، ما قد يضعنا في خانة الفوضى، وأن لا أسس سياسية أو قانونية أو أخلاقية تبيح للحاكم تقييد الحريات تحت أي ظرف، وفي هذا سنؤكّد على مقولة إدواردو غاليانو تلك التي سطرها على كتاب نعوم تشومسكي ” 501 الغزو مستمر “، والتي تذهب إلى أنّه ليس مُقدّراً للبشر أن يتحولوا إلى سلع، وأنّ العدالة الاجتماعية، بما فيها إعادة توزيع الثورة سيظل حلماً يداعب مخيلة الإنسان، ما ينفي مقولة فوكوياما عن نهاية التاريخ عند المرحلة الرأسمالية، ويضع حوار الحضارات محل صراعها، ذاك الذي بشر به صموئيل هنتغتون، في أعقاب سقوط منظومة الدول الإشتراكية، وإن كانت روابط الدفاع عن حقوق الإنسان – لتاريخه – تبدو عاجزة في تحقيق مهامها لغير سبب، ما قد يقتضي التنويه.