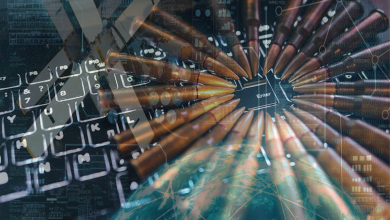من اللغة إلى الكينونة..
إنّنا إذ نقف بحقل العلوم الإنسانية، سنلاحظ صعوبة اجتراح تعريف جامع مانع لها – مصطلحاً وماهيات – وذلك على العكس من العلوم الوضعيّة، التي تحتكم إلى ضبط صارم يسوسها في الموضوعات أو العلاقات أو في ضبط المصطلح، فكيف إذا انتهى بنا المقام إلى تلمّس العلاقة بين موضوعتين كاللغة والكينونة؛ أي بين اللغة والهُويّة، بما هما حقلان شديدا التمفصل، بل التداخل؟! إلاّ أنّنا – في المجتبى – مُكرهون على ما ليس منه بدّ، ذلك أنّنا لا نجد مناصاً من تحرّي تلك العلاقة، وذلك للوقوف بموضوع راهن وضاغط وشديد الأهميّة، واضعين في اعتبارنا أنّ احتدام الحوار حول مسألة ما يضعها على تخوم النضج فاكتمال المحاور، على ألاّ يكون التوفيق أو التلفيق أو المنزلة بين المنزلتين في مقاصد أيّ طرف!
اللغة والكينونة.. مقدمات مفاهيمية
على هذا التأسيس سنعترف – بداية – بأنّ طرح المصطلحين المتلازم، يستبطن إقراراً ضمنياً بأنّ ثمّة علاقة بينهما، ما يستدعي أسئلة عن الدوائر التي يلتقيان فيها، وتلك التي يفترقان فيها إن وُجدت!
ثمّ أنّ طرحاً كهذا يلزمنا بالوقوف على اللغة بوصفها هوية، أي بما تحمله في داخلها من عناصر قوة، على نحو يدفعنا إلى الإيمان بها من جهة، والتمسّك بها من جهة أخرى!
تعالوا نتفق – إذاً – أنّ اللغة إذ نشأت أنيط بها وظيفة التواصل بين البشر أساساً، تلك هي الوظيفة الأولى والأساس لها، في حين أنّ الكينونة “الهوية” تحيلنا إلى الذات الفردية، تلك التي تنتمي إلى الذات الجماعية بمستوياتها المختلفة، التاريخية، الجغرافية، الثقافية، السياسية، الدينية، والحضارية بالإجمال!
لهذا سنتذكر سريعاً أنّ اللغة تعادل مصطلح اللسان، وأنّ طرحها إنّما يصدر عن العقل، فيما يتأتى الكلام عن الحاجة إلى التواصل؛ أي أنّ اللغة ملخّص للكلام البشريّ العاقل، على هذا يمكن القول بأنّ اللغة langue نظام اهتمام مستقلّ، وأنّ الكلام paroleهو تحقّق هذا النظام في صورة مُقرّرة، على نحو ينجز وظيفتي التعبير عن النص والتواصل مع الآخرين؛ أي أنّ اللغة إذ ترتبط بالهوية تتموضع في العقل، وليس على اللسان، ما قد يقتضي منّا التنويه!
اللغة والثقافة
أردنا أن نحدّد البدايات، فلا شكّ في أنّ اللغة هي التي تنتج الثقافة، إلاّ أنّ الثقافة – بدورها – تعتمد على وعاء لغويّ، بالاتكاء على هذا التأسيس سنلاحظ تداخل الدائرتين وتلازمهما، ذلك أنّ اللغة هي الفكر في تفاعله مع الأشياء، وموقفها منها، في حين أنّ الثقافة هي تشابك تلك الأشياء، إذ إنّها تملي علينا طريقة التعامل معها، وتحدّد استجاباتنا إزاءها! على هذا إذا كانت اللغة عنصراً في بناء الثقافة، فإنّ الثقافة تؤثر – هي الأخرى – في اللغة باعتبارها فكراً، وعلى هذا – أيضاً – ينبغي أن نمايز بين حقلين آخرين، إذ أنّنا مطالبون بالتفريق بين اللغة والثقافة من جهة وبينها وبين العلم من جهة أخرى، ذلك أنّ الثقافة إنّما هي نظرية في السلوك، في حين أنّ العلم نظرية في المعرفة!
اللغة والهوية في حالتي الصعود والهبوط
من المهم أن نشير إلى أنّ التواصل وظيفة مُجرّدة، محدودة القيمة، وتكمن أهمية التواصل في تأثيره إذ يرتد إلى الفكر، أمّا الهوية فتتمحور حول الذات والكينونة والماهية، هي قادمة من عالم الفلسفة – إذاً – في صورة مصدر صناعيّ، يقوم على النسبة، على هذا فهي تحيل إلى الانتماء والتساوي والتشابه، وهي تنحو إلى التركيب حين تعبّر عن جماعة أو أمة، ذلك أنّها ترتبط بمصالحهم وغاياتهم الجمعية، على هذا فهي لا تولد مع الإنسان، بل ترتبط بالمحيط كاللغة والثقافة بعلاقة جدّ وثيقة؛ أي بالمعنى التاريخي للمجتمع علوماً ومعارف ومواقف وذكريات ومشاعر وأفراحاً وتجارب، هذا كلّه يسهم في تشكيل هوية الجماعة في الزمان والمكان – الجغرافية – والدين بما هو رؤية الذات والآخر والكون!
ثمّ إنّ اللغة هي التي صاغت أوّل هُويّة؛ أي كينونة جماعة عبر التاريخ، فاللسان الواحد هو الذي صيّر فئة من الناس جماعة واحدة.
ويُلاحَظ أنّ أهمية العلاقة بين اللغة والهُويّة تزداد في المنعطفات التاريخية، لتتبدّى تصاعدياً في المنعطفات الحضارية الإيجابية، هل نستشهد بدور الدولة الإسلامية في بلورة هُويّة عربيّة، لم تنأ عن القداسة، باعتبار اللغة العربية لغة للقرآن الكريم!؟ لكنّها ستتبدى سلباً في الانكسار والتشظّي والغياب عن ساحة الفعل والتأثير، ولعلنا نقع على ضالتنا – تمثيلاً – في الموات القارّ للمنطقة العربيّة في ظلّ الإمبراطورية العثمانية!
ثم إنّ الصعود – منسوباً للإسلام – والهبوط – متموضعاً في خانة الخضوع للعثمانيين – سيتماهيان كشيء واحد! كيف؟! إذا وعينا بأنّ اللغة والهُويّة خصيصتان إنسانيّتان، اللغة هي لغة الإنسان، لأنّه الكائن الوحيد الذي يحوز الوعي، ويتحصّل عليه، الوعي والشعور بالذات، وبالآخر، على نحو يعيدنا إلى موضوعة ارتباطهما بالعقل؛ أي أنّهما خاصيّتان عاقلتان!
وإذا كنّا قد ألمحنا – سريعاً – إلى تشكلّهما في الزمن، فإنّنا إذ نقف بهذا التشكل مليّاً سنقول بأوليتهما، فهما قديمتان، وُجِدتا بوجود الإنسان على سطح البسيطة، وفي هذا قد نتذكر بأنّ الله “عزّ وجلّ” ميّز آدم بالعلم بالأسماء ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ سورة البقرة، الآية:31
وسنقول بأنّهما كلّ مركّب بلغة الفلسفة والمنطق؛ أي أنّهما كلّ تندرج تحته أجزاء، بهذا المعنى فهي تشتمل على طرائق التفكير والتاريخ والمشاعر والإرادة والطموحات وشكل العلاقات، وسنؤكّد على أنّهما – إلى ذلك – تاريخيتان، مترجمين وموضّحين – بذلك – ما أسلفناه من أنّهما تشكلتا في الزمن، وأخذتا بالتالي أبعادهما على تدرّج!
بقي أن نشير إلى أنّهما جمعيتان؛ أي أنّهما لا تعيشان داخل الفرد المنعزل، وها نحن – في حساب الجنى – نرى بأنّ اللغة والهُويّة إنّما هما وجهان لعملة واحدة؛ أي أنّ الإنسان في جوهره ليس سوى لغة وهُويّة، اللغة بما هي فكره ولسانه، وفي الوقت ذاته بما هي انتماؤه، انتماؤه الفردي؛ أي تمايزه كذات، وانتماؤه الجماعيّ، واندماجه بها، وفي المجتبى بما هي هُويّته!
هذا فيما يخصّ الدوائر التي يلتقيان فيها، أمّا تلك التي يفترقان فيهما فقد تتلخّص في حالة الهزيمة التي تحيق بأمّة مثلاً، ذلك أنّنا – إذاك – سنجد ارتباكاً واضحاً في التعبير عن الهُويّة – وسيقتصر حديثنا عليها فيما يلي – في الخطاب الرسميّ العربي، وذلك في أعقاب هزيمة حزيران 1967، ناهيك عن أنّ تلمسها عند النخب الثقافية بدا – هو الآخر – مُلتبساً، يشكو الاضطراب والإبهام!
يضاف إلى ما تقدّمَ غياب المشروع المُعبّر عن طموحات البشر وآمالهم، وسنجد التعبير عن هذا الغياب في تسيّد الخطاب القُطريّ على حساب الخطاب القوميّ، ذلك أنّه – أي الخطاب القطري – وأد – وإلى أمد غير معلوم – تطلعاً – يشكو الإبهام أساساً – إلى وحدة الصف!
ثمّ إنّ العرب المسلمين إذ أخرجوا من الأندلس – على يد ملوك قشتالة “إيزابيلا وفرديناند” في اتحادهما – إنّما كانوا يستقيلون من التاريخ، ما سيشي – لاحقاً – بغياب وعي الأنا الحضاريّ لأمد طويل!
فهل نتذكّر بأنّنا إذ نقف اليوم – حتى – بالعامل الدينيّ بما هو عامل موحّد، سنفاجأ بأنّ انقسامه المذهبيّ صيّره عامل تشظ وقسمة وافتراق؟!
اللغة الكردية أنتجت الهوية القومية للكرد
ثمّ إنّنا إذا انتقلنا إلى الحيز الكرديّ أشكلت اللوحة أكثر فأكثر، ربّما لأنّ غياب الكيان الكرديّ أعاق عملية الحفر التاريخيّ، ناهيك عن أنّ الدول التي اقتسمت كردستان حجبت نتائج الحفر أو الدراسات الأثريّة، تلك التي تشير إلى وجودهم، أو إلى دورهم في ميزوبوتاميا، تلك هي الحال في التاريخ القديم، ما أوكأ تاريخهم – ذاك – إلى سطوة التخمين أو الترجيح دون التوكيد، أو إلى ما تواتر من دراسات البعثات الأثرية الغربية بعد نشرها في الدوائر العلمية هناك، منوّهين إلا أنّ تواترها لم يكن منتظماً، فإذا انتقلنا إلى العصر الوسيط طالعتنا الدولة الإسلامية، لتشكل الحدث الأبرز فيه، ليس في ميزوبوتاميا فحسب، بل في المنطقة الممتدة بين بحر الظلمات “المحيط الأطلسي” غرباً، وحدود الصين شرقاً، ومن أواسط آسيا شمالاً، إلى أفريقيا شمال الصحراء جنوباً.
لقد دخل الكرد الدين الجديد، فلم يشتغلوا على إنشاء كيان متمايز، ذلك أنّ الدول القومية – بمفهومها المعاصر – لمّا تكن قد تحقّقت بعد، بل أنّها لم تكن مطروحة على مستوى الذهن، على هذا عدّت الدولة الأيوبية امتداداً للدولة الإسلامية، ولم تشكّل قطعاً لها، وعلى هذا – أيضاً – لم تظهر اللغة ولا الهُويّة كإشكالية بالنسبة للكرد في تلك الحقبة!
أمّا اليوم فإنّ الكر يعيشون وضعاً بالغ التعقيد على مستوى اللغة لا الهُويّة، ذلك أنّ اللغة الكردية أنتجت هُويّنهم القومية تاريخياً، هذا إذا تذكّرنا ما أسلفناه من أنّ اللغة هي التي تنتج الهُويّة، في حين أنّ الهُويّة لا تنتج لغة، بيد أنّ انقسام كردستان على أصابع الدول، انقسامها الأول في أعقاب معركة جالديران 1524 بين الفرس- الصفويين، والترك- العثمانيين، وتكسّرها اللاحق بين سوريا وتركيا والعراق وإيران فرض على الكرد سياقاً مربكاً وغير مسبوق، إذ حجب لغتهم عن التداول الرسميّ في الحدّ الأدنى، وفرض عليهم لغة الدول التي هيمنت عليهم، لتنفي بعضها وجودهم ككلّ – تركيا – وتتراجع لغتهم لمصلحة تلك اللغات في بقية الدول التي تقاسمتهم، مدّعية بأنّ ليس ثمّة لغة كردية، وأنّ الكردية المتداولة – هنا وهناك – إنّما هي مجرّد لهجات تفتقد الألف باء، ناهيك عن افتقادها للتدوين!
لقد خاض الكرد نضالاً شرساً للتحصّل على حقوقهم، وقد نتذكّر – في هذا السياق – ثورة الشيخ عبيد الله النهري 1880، أو ثورة الشيخ سعيد بيران 1925، أو ثورة الشيخ محمود الحفيد، فثورة الملا مصطفى البارزاني، أو انتفاضات آكري وساسون على سبيل التعداد لا الحصر، ثمّ إنّهم كادوا أن يحققوا كياناً خاصّاً بهم في مهاباد 1946 – كردستان إيران – لكنّ الجمهورية الوليدة – التي أعلنها القاضي محمد – لم تصمد طويلاً، ربّما لأنّ العالم الذي – كان قد خرج لتوّه من حرب كونية ضروس 1939 / 1944- لم يأبه لرغبات أولئك البشر!
أمّا اليوم فسيسجّل الكرد تمايزاً عن الأقوام المجاورة، بل المهيمنة، بسبب من التحدّي الذي واجهوه في صورة إنكار أو كبح وضبط ولجم، تحدّ وجوديّ – إذا جاز لنا التعبير – نقلهم من حالة استنقاع قبليّ – عاشتها الأقوام التي خضعت للإمبراطورية العثمانية طويلاً – إلى خانة العمل السياسيّ، على ما قد يشوب هذا العمل من ملاحظات أو أخطاء أو نواقص، بسبب من غياب صيغة العقد الاجتماعيّ التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم من جهة، وما استتبعه هذا الغياب من فهم ناقص للأحزاب بما هي تعبيرات اجتماعية راقية عن مصالح متباينة من جهة أخرى!
سنسجّل للأحزاب أنّها نقلت الجمهور الكرديّ بمجمله إلى خانة العمل السياسيّ إذاً، من غير أن نزعم بأنّهم – ككلّ – انخرطوا فيه، إذ ليس ثمّة شعب على وجه الكرة الأرضية منشغل بأكمله بالشأن العام، لكنّ ارتباك تلك الأحزاب في التعبير عن مشروعهم، وإبهام المشروع ذاته، بل تداخله أو تناقضه، ناهيك عن مستوى تطوّرهم الموضوعيّ، وغياب الوعي الذي يحكم طبيعة العمل السياسيّ، وضغط الدول المهيمنة عليهم، أوقعهم في فخّ الانقسام والتشرذم، بشكل لا يمكن معه أن ننسب هذا التشرذم إلى التعدّدية، ربّما لأنّ الإرث الديموقراطيّ كان ضئيلاً جداً، هذا إن لم نقل بانتفائه، على نحو قد يسم أحكامنا بالعسف أو بالشبهة أو بالهوى!
وبالعودة إلى موضوعة اللغة ستفرض السلطاتُ العربية والتركية والفارسية لغات رسمية على الكرد، مرة لأداء فرض دينيّ – العربية – ومرة بحثاً عن عمل وظيفيّ، أو لمتابعة الدراسة، أو هرباً من عسف الأجهزة، أو لتماهي الضعيف بالقوي بحسب عالم الاجتماع الجليل ابن خلدون في مقدّمته الشهيرة، ما حجب عن الكردية إمكانية التطوّر والتطوير، ذلك أنّ التطوّر يستدعي اشتغالاً دؤوباً غير متاح، على هذا ستتضاءل حركة التأليف بها إلى حدودها الدنيا، فلا تعود المكتبة الكردية تلبي حاجة جمهورها العريض في المجالات كافة، ولن تترجم كتب العلوم والصنائع والآداب والفلسفة والفنون أو التاريخ إلى اللغة الكردية إلاّ في أضيق نطاق، فتصاب بالفاقة والإملاق، وتحتكم إلى الشلل أو تكاد!
دعوة للاشتغال على اللغة الكردية
ثمّ ماذا عن منتجي الثقافة من الكرد، أولئك الذين تعلموا لغات الدول المهيمنة على كردستان، وقيّض لهم أن يقفوا بأسرار تلك اللغات، ويعوا فقهها بعمق، ليشتغلوا في الحقل الثقافيّ بتلك اللغات؟! ترى أين سيُصنفون؟! هل سيُحسبون على الثقافة الكردية، أم أنّهم سيُعدّون جنوداّ في خدمة الثقافات المهيمنة، تلك التي أتينا عليها، ذلك أنّ اللغة ليست وسيلة تعبير فحسب، بل إنّها وسيلة تفكير أيضاً، فنحن نفكّر بوساطة اللغة، ناهيك عن أنّها حامل للأفكار الجمعية ووعاء؟! حسناً.. ألن يحتكموا إلى ازدواجية – أو تشوّش – في الانتماء حتى؟! وفي الردّ ستتباين الإجابات، ذلك أنّ البعض سيحسبهم على الثقافة الكردية، ذاهباً إلى أنّ هؤلاء يعبّرون عن همّ كرديّ، ويكتبون في موضوعات كردية، في حين أنّ آخرين سيضعونهم في خدمة الثقافات التي يشتغلون بها، وذلك بالاتكاء إلى الحجج والأسانيد المُسلفة!
فهل نحسم المسألة بأنّ حسابات كهذه نسق يتداخل فيها الثقافي بالسياسيّ والاجتماعيّ، وأنّ الديموقراطية – إن وُجدت – ستسمح لتلك الثقافات أن تتلاقح وتغتني، فيُعبّر الجميع عن أنواتهم بحرية؟! ولكن ألسنا – على نحو لا شعوريّ – نتحاشى استحقاقات أزفت بالتحوير – حيناً – أو بالإسقاط والتدوير أو التبرير؟!
وعلى نحو شخصيّ – باعتبارنا أحد المشتغلين بالثقافة، والمنشغلين بها – سنقرّ بأنّنا كنّا في خدمة الثقافات المهيمنة ولا نزال، هي ليست دعوة للتخلي عن الكتابة بالعربية أو بالتركية والفارسية، ولكنّها دعوة إلى الاشتغال على الثقافة الكردية – في افقها الإنساني – وباللغة الكردية إلى جانب تلك اللغات، مذكّرين بأنّ اللغة الكردية أنتجت الهُويّة والثقافة الكرديتين، وأنّ الثقافة الكردية تحتاجنا للاشتغال عليها، فنبعد عنها البؤس، ونرفعها إلى المكانة التي تستحقها إلى جانب اللغات المتداولة في المنطقة، ما قد يقتضي التنويه مرة ثانية!